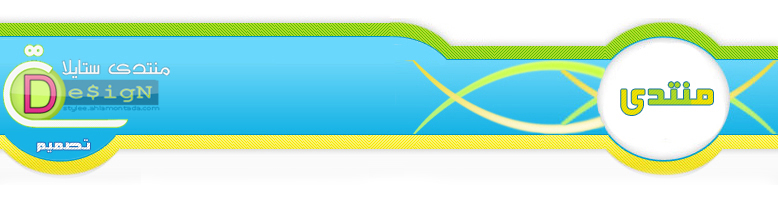تكمن أهمية علم النفس والتحليل النفسي بالنسبة للنقد الأدبي والأدب في أنه مظلة واسعة تندرج تحتها عدة مسارات هامة: النمو الإنساني ومراحله من الطفولة إلى سن الرشد، وعملية التأويل والتحليل، وكذلك فاعلية الاستشفاء والعلاج. وعلى الرغم من إمكانية فصل هذه المسارات عن بعضها إلا أنها في النهاية تعود لتختلط بمفاهيم الجسد والعاطفة والعقل وتاريخ النمو والتجربة الشخصية. ومن ثم تشتبك مثل هذه المفاهيم الشخصية الفردية بالإطار الثقافي والاجتماعي. فمن منظور النمو تركز النظرية النفسانية على وصف تتابع أفعال النمو ومراحله: كيف ينمو المرء في عملية من المد والجزر (التقدم والانحسار، الانعتاق والكبت) خاصة فيما يتعلق بمراحل النمو الجنسي، وكيف يبني المرء أنساقاً نفسية وعاطفية تتداخل مع علاقاته الأبوية (الأسرية) والاجتماعية والثقافية: انساقاً قد يقبلها أو قد يرفضها. وكيف يتفاعل مع البيئة العاطفية والمادية التي يسكنها ويعيش ضمنها فيعكسها أو يقاومها. وهكذا لا تقتصر نظرية علم النفس على خصوصية شخصية محددة بل هي تحاول دائماً ربط الخصوصية بعواملها الإنسانية والمادية والزمانية ومن ثم ربطها بالإطار الأسري والاجتماعي والثقافي والحضاري.
ومهما قيل عن أن علم النفس يضرب جذوره في حوارات أفلاطون (تأثير المحاكاة العاطفي على حراس الجمهورية الفاضلة) وفي رد أرسطو (المحاكاة تفضي إلى التطهير النفسي للمشاهد أو المتلقي)، فإن التحليل النفسي في النقد والأدب برز فعلياً مع سيغموند فرويد الذي يرى أن العمل الأدبي موقع أثري له طبقات متراكمة من الدلالة ولا بد بالتالي من كشف غوامضه وأسراره، ولئن كان للتحليل الفرويدي أنصاره في النقد الحديث فهذا لا يعني أن التحليل النفسي الفرويدي نفسه لم يتغير ويعيد النظر في مصطلحاته وأطروحاته. بل إنه تعرض كغيره إلى ضغوط التوجهات الجديدة، وتأثر بفرضيات إنتاج النص واستقباله وتغير مفاهيم اللغة وأهميتها وأساليب تقديم الشخصية وعرضها، وما إلى ذلك، لكن بقيت الأرضية الفرويدية (اللاوعي) قائمة كمركز الاهتمام، وفكرة اللاوعي تقوم على مقولة أن المرء يبني واقعه في علاقة أساسية مع رغباته المكبوتة ومخاوفه. ولهذا فإن كل تعبير (سلوكاً أو لغة أو خيالاً) هو مجموعة علاقات معقدة تتوسط وتتدخل في كل ما يعتقد المرء أنه يفعله أو يقوله أو يحلم به، واللاوعي يضرب جذوره في البنى العاطفية والجسدية للحياة الجنسية التي يفترض إشباعها أو كبتها، كما لا يعني هذا أن التحليل النفسي لا يتواءم مع غيره من النظريات النقدية أو أنه يلغيها، بل هو يضيء كثيراً منها خاصة أنه يتعامل مع ويهتم بتمثيل الذات والآخر والجسد والعواطف والعلاقات التي تحكم فعاليات السلوك والخطاب، أي طرق تحويل وترجمة الرغبة والحدث والتجربة إلى ذاكرة وإلى فعل لغوي. ولعل السمة التي لا يتجاوزها التحليل النفسي هي أنه يتبع كافة خيوط العمل الأدبي إلى وعي ولا وعي الذات: ظروفها النفسية وسيرتها الذاتية وتاريخ نموها. ويصبح العمل تعبيراً عن رغبة ما ومحاولة إشباعها سواء كانت الرغبة ناتجة عن علاقة المرء بذاته أو بالبيئة أو العالم من حوله.
ومع فرويد أصبح العمل الأدبي والفني عموماً (وكذلك الأحلام والكوابيس والأعراض العصابية) يتكون من محاولة إشباع رغبات أساسية متخيلة كانت أم وليدة عالم الفانتازيا. ولا تكون الرغبة رغبة ما لم يحل بينها وبين الإشباع عائق ما: كالتحريم الديني أو الحظر الاجتماعي وأعراف القوم وتقاليدهم. وهكذا يحول "الرقيب" بين الرغبة وبين إشباعها سواء كان "الرقيب" هو الوازع الديني أو الأخلاقي أو العرفي الاجتماعي. ولهذا فالرغبة الحبيسة تستقر في مملكة اللاوعي من عقل الفنان أو الأديب (الإنسان عموماً) لكنها تجد لنفسها متنفساً أو قد يسمح لها الرقيب بأن تشبع نفسها خيالياً من خلال صيغ محرفة وأقنعة من شأنها أن تخفي طبيعتها الحقيقية وتخفي موادها عن الأنا الواعية. وهنالك آليات دفاعية لدى الرغبات تستخدمها حتى تتجاوز الرقيب فتحقق الإشباع. من هذه التحريفات والأقنعة: (1) التكثيف: حذف أجزاء من مواد اللاوعي وخلط عدة عناصر من آليات تحريفية حتى يستطيع تطويعه وبالتالي تجاوزه والخلاص من هيمنته، أما جاك لاكان فيجمع بين النظريات الألسنية اللغوية وبين معطيات النظرية الفرويدية بعد أن واءم بينها وبين المفاهيم اللغوية حتى يتسنى له جعل اللغة مادة للتحليل النفسي.
ومع التطورات الحديثة المتعلقة بتشظي (الذات) وتغير مفاهيم (الحقيقة) كان على التحليل النفسي أن يكيف نفسه حسب هذه المتغيرات. فإذا كانت (الذات) مجموعة علاقات متشابكة منها الشخصي ومنها غير الشخصي، والحقيقة لم تعد متعالية على اللغة التي تنسجها وتبنيها، فإن على علم النفس أن يبرر ويفسر سيرورة العملية التي تبني "الذات" وتبني مفهوم "الواقع" ولهذا أصبح الفنان كما أصبح المحلل النفسي على وعي تام بتداخل أفكاره وعواطفه وتجاربه في عملية التحليل وفي نتائجه، كما أصبح مركز الاهتمام منصباً على العلاقة بين الوعي واللاوعي وليس على الكيفية التي يملي بها اللاوعي شروطه على الوعي وعلى السلوك الفردي. فلم يعد اللاوعي منطقة معزولة تؤثر على الوعي فقط، بل أصبح التأثير متبادلاً بين المملكتين إضافة إلى تدخل وعي ولا وعي المحلل النفسي أو الناقد الأدبي. وهكذا أصبحت العملية حركة صيرورة مستمرة بين الوعي واللاوعي من جهة وبين وعي ولا وعي المحلل من جهة أخرى. ومع هذه الخصائص أصبحت عملية التأويل عملية مستمرة وليست حدثاُ يبدأ وينتهي، أي أصبحت عملية مفتوحة، كما هي حال النص الحديث "المفتوح" الذي يقابل العمل المغلق، ولعل جاك لاكان هو بطل التحليل النفسي في الدراسات الأدبية، فقد وظف المقولات الألسنية اللغوية التي نادى بها سوسير ونادى بها ما بعد البنيويين وأرسى أسس التحليل النفسي عليها. ونتيجة لذلك توصل لاكان إلى شعاره المألوف: "إن اللاوعي مبني كما تبنى اللغة".
ومهما يكن من أمر التحليل النفسي وتعقد قضاياه فإن فرضياته التقليدية ما زالت قائمة: 1- هناك دائماً تفاعل بين حياة المؤلف أو القارئ أو المحلل النفسي وبين رغباته وأحلامه وتخيلاته الواقعية وغير الواقعية.
2- يسعى التحليل النفسي دائماً إلى كشف أسباب ودوافع خفية عند المؤلف أو القارئ أو المحلل.
3- معاملة الشخوص في العمل الفني على أنهم أشخاص حقيقيون لهم دوافعهم الخفية وتواريخ طفولتهم المتميزة وعقولهم الواعية وغير الواعية. ولهذا تنحصر موضوعاته السائدة في النزعات الإجرامية والعصاب والذهان والسادية وتعذيب الذات، والانحراف الجنسي، وعلاقة الأب بالابن، أي العلاقة الأوديبية، ولتغطية مثل هذه المواضيع فإن التحليل النفسي يفضل الروايات والمسرحيات على القصائد (خاصة القصيرة منها).
متعلقات
النقد من منظور القارئ(1)
تفترض عملية التواصل لكي تكون فعالة وجود انساق مشتركة بين المؤلف وقرائه، أي نسق اللغة، وأيضا الأنساق الجمالية والايديولوجية. يتعين إذن معرفة "من كان يقرأ – أو من يقرأ، ولماذا": ومعرفة "التكوين الذي تلقاه الكتاب في المدرسة أو خارجها – والتكوين الذي تلقاه كذلك قراؤهم".
لا يحيا العمل الأدبي إلا إذا قرئ، و»بدون عملية القراءة هذه ليس هناك سوى تخطيطات سوداء على الورق«، كما لاحظ ذلك سارتر في بداية كتابه »ما الأدب؟«؛ غير أن القراءة عملية صامتة لا تترك أثرا مكتوبا، إلا ما ندر؛ وهي من صنيع أفراد معزولين، وفي غالب الأحيان غير معروفين. كل هذا يفسر بدون شك لماذا بقي القارئ لمدة طويلة مهمل النظرية الأدبية.
لقد قدم ميشال كونتا منذ عهد قريب، في جريدة لوموند، أعمال ندوة انعقدت في رانس سنة 1992، لمعرفة »كيف يفعل الأدب«. وعنوان دراسته »عَقد القارئ« جعل من اهتمام النقد اليوم بشخصية القارئ الحدث البارز في السنوات العشر الأخيرة؛ لكن هذا التغيير في توجه الدراسات الأدبية قد مهد له ظهور نظريات القراءة في السبعينيات. وكتاب فنسان جوف في »القراءة« صدر في سلسلة »معالم أدبية« عن دار هاشيت، سنة 1993، يصفها ويحللها تحليلا دقيقا: فتطور اللسانيات قد أهمل وصف سنن اللغة ووجه اهتمامه إلى »أفعال الكلام« وتحققها الفعلي؛ وبذلك ساهم كثيرا في دراسة موضوعية لظاهرة كانت إلى ذلك الحين صعبة التحليل.
وتصف اللسانيات التداولية - التي تطورت خاصة في انجلترا والولايات المتحدة - تأثير المتكلم في المرسل إليه، وتبين أيضا كيف أن المرسل إليه، إذ يتبنى الملفوظ لحسابه، يحول عبارات لها دلالات في نسق اللغة إلى جمل ذات معنى في حالات معينة وفي سياق بعينه.
لقد حولت التداولية مشهد الدراسات الأدبية بإعادتها الأدب إلى وظيفته التواصلية التي حجبتها البنيوية النصية. ومنذ سنة 1973 أعلن هنري ميشونيك في كتابه »لأجل الشعرية«، عن »نهاية الحماقات التي تعدّ أن فعل الكتابة فعل لازم«. فقد أصبحت الكتابة غير منفصلة عن »قول شيء ما لشخص ما«. ولذلك سننهي مسيرتنا عبر حقول النقد محاولين أن نستوعب كيف استطاع التبئير النقدي على فعل القراءة أن يحول طريقة التفكير في الأدب، ويفسر من الآن فصاعدا اشتغال النص من خلال الدور الذي يلعبه المرسل إليه في تكونه، وأيضا في فهمه وفي تأويله؛ لأن الأدب يشّيد تواصلا مؤجلا بين كاتب ما وقراء ليسوا بالضرورة كلهم معاصرين بعضهم لبعض، ولا حاضرين جميعهم في المكان نفسه.
لقد أهمل التاريخ وسوسيولوجيا الأدب، منذ سنة 1950، تحليل العمل الأدبي في علاقته بمؤلفه، أو بالعالم الممثل، واهتما، تحت التأثير القوي لسارتر، بالتواصل المؤسس بين المؤلف وجمهور القراء - الواقعيين أو المفترضين - الذين يتوجه إليهم. وتفترض جمالية التلقي، بتجاوزها لسوسيولوجيا الأدب، أن العمل الفني هو دائما عبارة عن معنى ممكن؛ فهو سؤال وليس جوابا؛ وترفض »معنى المؤلف«، وتقابله بالمعاني المختلفة التي يعطيها القراء لنفس العمل على مر الزمن.
وبالموازاة مع هذه التحليلات التاريخية للأحداث التجريبية للقراءة، طور ميكائيل ريفاتير نظرية القارئ المثالي، أو »القارئ الجامع«، مبينا الكيفية التي يوجه بها النص الأدبي تلقيه ويبرمجه. لقد تمت إذن مراجعة تحليل البنيويين الشكلي، وأصبح في خدمة نظرية القراءة.
وبالقرب منا، يشتغل المحللون النصيون، مع جان بلمان نويل منذ سنة 1983، على إعادة تحديد مفهومي التناص ولاوعي النص، مبينين إبداعية القراءة، ومغيرين إشكالية المعرفة النقدية. إن الاهتمام بـ»حقيقة العمل الأدبي«. قد تم التخلي عنه لصالح التفكير في فعالية الفعل النقدي، سعيا لحث الناقد وقارئه على إحياء »شحنات المعاني المتعددة، بل الخفية« الساكنة »بين سطور« العمل الأدبي.
تاريخ القراء
»سوسيولوجيا الأدب«
أصدر روبير إسكاربيت تحت عنوان »سوسيولوجيا الأدب«، سنة 1985، مؤلفا - برنامجا يحدد أهداف دراسة الشروط المادية والاقتصادية والاجتماعية ومناهجها لإنتاج الأعمال الأدبية ونشرها واستهلاكها، يستجيب به للأماني التي عبر عنها لانصون، في نص كتبه سنة 1929، عنوانه »برنامج دراسات التاريخ المحلي للحياة الأدبية«، ولوسيان فيبر سنة 1953، في »صراعات لأجل التاريخ«، وكلاهما يتمنى مجيء »تاريخ تاريخي« للأدب (فيبر) يأخذ بعين الاعتبار »القراء، هذا الحشد الملتبس الذي ينبغي معرفة ثقافته ونشاطه، إذا كان المراد كتابة [...] تاريخ شروط الأدب الاجتماعية والثقافية« (لانصون).
وعلاقة العمل الأدبي بالعالم الذي شهد ولادته قد درسها شكل آخر من أشكال النقد السوسيولوجي، هو سوسيولوجيا لوسيان غولدمان على سبيل المثال؛ لكن يجب أن تكتمل بتحليل علاقة العمل بقرائه. ويستعمل كل من روبير إسكاربيت ومدرسة بوردو لأجل ذلك مناهج لم يكن يعرفها لانصون. فهم يشتغلون على شكل مجموعات، ويطبقون على تاريخ الأدب الطرائق والإجراءات الجارية في »التاريخ السوسيولوجي«، »المهتم بالفعاليات والمؤسسات، لا بالأفراد« (بارط في »تاريخ أم أدب؟«، 1960). ويندرج تفكيرهم داخل الإطار النظري الذي رسمه سارتر في كتابه »ما الأدب؟«، الذي صدر سنة 1948.
لقد كان لسارتر دور هام في تحولات النقد الحديثة، إذ وضع القارئ والقراءة في مركز تفكيره حول الأدب. فقد أكد في كتابه »ما الأدب؟«، في الفصل الثالث منه، وعنوانه »لمن نكتب؟« - وهو الذي يتلو الفصلين المعنونين »ماذا يعني أن نكتب؟« و»لماذا نكتب؟« - وهو حجر الزاوية في الكتاب، أننا نكتب دائما لأحد ما، وليس »لذاتنا أو إلى الله«، كما »ابتدع« ذلك كتاب ما بعد سنة 1850، إذ جعلوا »من الكتابة اهتماما ميتافيزيقيا، وصلاة، وامتحانا للضمير، فجعلوا منها كل شيء، إلا أن تكون تواصلا«. فهو يعارض نظريات الأدب المعروضة في الفصول السابقة، أي النظريات التعبيرية المنشغلة فقط بالطريقة التي يعبر أنا المؤلف عن نفسه في العمل، وبالنظريات الشكلانية المستوحاة من كانط والكانطية التي ترى »العمل في ذاته«، باحثة في نص ما عما يقوله، في استقلال عن مقاصد مؤلفه. أما سارتر، فلا تهمه سوى العلاقة بين العمل والقراء؛ فهو يعطي الجمهور الأهمية التي يعطيها تين »للوسط«: »فالوسط قوة تضرب في الماضي؛ والجمهور بخلاف ذلك توقع، وفراغ يجب ملؤه، وتطلع، بالمعنى المجازي وبالمعنى الحقيقي«. إنه يسلم مبدئيا بأن فعالية التواصل تفسر العمل أكثر مما تفسره علاقته المحاكاتية مع العالم الخارجي.
وتفترض عملية التواصل لكي تكون فعالة وجود أنساق مشتركة بين المؤلف وقرائه: أي نسق اللغة، وأيضا الأنساق الجمالية والإيديولوجية. يتعين إذن معرفة »من كان يقرأ - أو من يقرأ، ولماذا«؛ ومعرفة »التكوين الذي تلقاه الكتاب في المدرسة أو خارجها - والتكوين الذي تلقاه كذلك قراؤهم«؛ ويتعين أيضا وصف »تحولات الموضة الفنية والذوق« (لوسيان فيير). فبالبحوث في قراءات مختلف الطبقات الاجتماعية يعرف القارئ من خلال »الجمهور« الذي ينتمي إليه. ولابد أيضا من تتبع المسار الاجتماعي للمنشورات الأدبية ورسم مراحله، لأن أنماط الإنتاج المادي وأنماط نشر العمل تحدد الطريقة التي »يفعل بها الأدب«. وتاريخ الكِتاب يأتي لتكملة تاريخ القراء. ويقدم كلود بيشوا، في مقالة له حول »دكاكين القراءة في النصف الأول من القرن التاسع عشر«، فكرة دقيقة عن النتائج التي يمكن أن تتوصل إليها سوسيولوجيا الأدب. ودكاكين القراءة هذه كانت تطل على الشارع، شأنها شأن المتاجر، وكانت مفتوحة من الثامنة صباحا إلى الحادية عشرة مساء؛ وقد ظلت تتكاثر إلى حدود سنة 1863، وتقوم بإعارة الكتب والجرائد، وفي الوقت نفسه كانت مكان التقاء الكتاب والقراء. لقد ساهمت هذه المؤسسة كثيرا في نجاح الرواية في القرن التاسع عشر، وخلقت جمهورا لهذا الجنس - خصوصا من النساء، من الخادمات أو من نساء البورجوازية الصغيرة والمتوسطة - وقادت كبار الكتاب نحو هذا الجمهور. فلأجل دكاكين القراءة هذه كتب بلزاك في بداية مشواره روايات كان يوقعها بأسماء مستعارة.
تبين سوسيولوجيا الأدب إذن الدور الذي يضطلع به جمهور القراء، من خلال قيمه، وأذواقه، وتوقعاته، في تكون الأعمال الأدبية ونجاحها المباشر. لكن حجتها الوحيدة لتعليل النجاح الدائم أو المتأخر هي مسألة الإعجاب المنتزع. وتحاول جمالية التلقي، التي ظهرت في عقد السبعين من [القرن الماضي] مع هانس روبرت ياوس ومدرسة كونسطانس، أن تجيب عن هذه الأسئلة التي أبعدتها سوسيولوجيا الأدب.
جمالية التلقي عند هانس روبرت ياوس
تفترض سوسيولوجيا الأدب أن الكتاب يكلمون معاصريهم، وأن »الأعمال الفكرية [...] يجب أن تستهلك في حينها«، مثل »الموز، يكون ألذ وقت جنيه« (سارتر). ونعرف مع ذلك أن بعض الأعمال الكبرى لم تلق نجاحا كبيرا وقت صدورها، لكن جمهورها تكَّون بعد ذلك بمدة طويلة. فرواية »التربية العاطفية« كان تلقيها سيئا في سنة 1869، واتهمت بأنها »رواية غير روائية، حزينة، وملتبسة كالحياة« (بانفيل)؛ وأضحت فيما بعد معبودة الأجيال اللاحقة: فقد أعجب بها بروست، وكافكا، ويعدها وودي ألن »من الأشياء التي تجعل الحياة تستحق أن تعاش«.
ولاستجلاء القطائع أو الانزياحات التي تشوب علاقة المؤلف بجمهور عصره، ابتدعت جمالية التلقي مفهوم »أفق التوقع«. ويتكون »أفق التوقع« عند جمهور ما من القراء من خبرته السابقة بالجنس الذي ينتمي إليه العمل الأدبي، ومن تراتبية القيم الأدبية لعصر ما. هذا »الرأي العام الأدبي« يمكن قراءته في نص العمل نفسه، لأنه يحيل ضمنيا على أشياء سبقت قراءتها، وعلى عادات في القراءة يروم تحويلها. فليس موضوع الدراسة إذن هو الموقف الفردي والسيكولوجي لقراء معزولين، بل هو التجربة الجمالية المشتركة التي تؤسس كل فهم فردي للنص.
ويفسر مفهوم »أفق التوقع« أيضا آليات تلقي الأعمال والتطور الأدبي. فإذا كان العمل يعيد إنتاج خصائص إنتاج سابق، فإنه سيعرف نجاحا فوريا، لأنه يثير لدى قرائه لذة التعرف؛ أما إذا كان العمل الجديد يخرق قوانين الجنس، فيغير معيارا جماليا ما، فإنه يفشل، أو لا يفهم في حينه، وذلك لأنه لا يستجيب لآفاق جمهوره الأول؛ لكنه يصبح فيما بعد عملا - نموذجا. ففي سنة 1870، كانت جورج ساند تقول لفلوبير: »ما زالوا يدمرون كتابك. وهو مع ذلك كتاب جيد. لكنه سينصف فيما بعد«. فبمقتضى التقليد الذي يقول بـ»الرواية الروائية«، وبمقتضى نموذج الرواية الكلاسيكية، وهو الرواية البلزاكية - المبنية بناء مأساويا - استطاع الجمهور المعاصر لفلوبير أن يحكم بأن »التربية العاطفية ليست رواية«. وبالمقابل، سيجعل كتّاب »الرواية الجديدة« من فلوبير معلمهم، وبذلك سيعتبرون أن صلاحية »الرواية البلزاكية« قد انتهت: لقد فرضت الكتابة الروائية عند فلوبير بقوة معيارا جماليا جديدا.
سلطة الكاتب(3)
بدأ الاهتمام بالكاتب (أو المؤلف أو المبدع) مع نشأة العلوم البيولوجية والدراسات السيكولوجية. وظهر هذا الاهتمام في المدرسة النفسية، والمدرسة الرومانسية. فإذا أخذنا المدرسة النفسية في الأدب والنقد نموذجاً على (سلطة الكاتب) تبين أن أول من عني بالتفسير النفسي للأدب هو الناقد الفرنسي (سانت بيف) الذي أنشأ سلسلة من المقالات باسم (صور المؤلفين)، ممهداً بها لنقد يحاول اكتشاف (نفسيّة المؤلف)، حيث جمع مواد كثيرة عن أصول المؤلف، ونشأته، وسيرته الذاتية، وعلاقته بمجتمعه، من أجل كشف الحالة النفسية التي تسلطت على الأديب أثناء إبداعه الأدبي.
كذلك اهتم (كولردج) بذاتية الأديب، فوضع كتاب (السيرة الأدبية) عام 1817 عدّه النقاد (إنجيل النقد الحديث). وقد أثار فيه قضايا أدبية، منذ اختمارها في نفس الكاتب، حتى ظهورها في شكل فني.
ثم جاء فرويد (1856-1939)، فتجاوز المقولات التي تردّ الإبداع إلى الإلهام أو الواقع الاجتماعي، وجعل اللاشعور الشخصي هو المصدر الحقيقي للإبداع. فالإبداع ـ حسب فرويد ـ هو تنفيس عن الصراع المعتمل داخل الشخصية، والمتمثل في القمع والكبت، والمتطلع إلى أنواع شتى من السلوك، أرفعها التسامي الذي يؤدي إلى إظهار العبقرية. وهو رغبة لم تجد تلبية لها في عالم الواقع، فانصرفت إلى عالم الخيال. وبهذا يبدو الإبداع تعويضاً عن غرض أدنى بغرض أسمى.
وبوساطة التسامي يفرغ الأديب شحنته، مستبدلاً الهدف الذي لم يحققه بهدف ذي قيمة اجتماعية كالكتابة الأدبية. وعلى هذا فإن فرويد يرى الأدباء والفنانين مرضى يخفون عقدهم في إبداعهم. ومهمة الناقد هي البحث في التحولات التي أجراها المبدع لتغطية مكبوتة بمكتوبة.
وعلى الرغم من أن (فرويد) يعترف بعجز التحليل النفسي عن إدراك طبيعة الإبداع الأدبي والفني، فإنه نشر ثلاث دراسات عن التحليل النفسي للأدب، عن ليوناردو دافنشي، ودستويفسكي، وينشن: ففي دراسته لدافنشي بنى سيرة للفنان ولمكبوتاته الجنسية التي ظهرت في شذوذه الجنسي. وفي دراسته لدستويفسكي عني بتفسير الصراع الهستيري الذي كان يصيب دستويفسكي، ورغبته الأوديبية في قتل الأب.
وقد حقّق التفسير النفسي للأدب فتوحات جديدة: فقد كان تردد (هاملت) مثلاً يُرَدُّ ـ في المناهج النقدية القديمة ـ إلى جبنه، وإلى تأمله الذي أضعف قدرته على العمل، فأصبح ـ في التفسير النفسي ـ يُرَدُّ إلى ضراوة الصراع النفسي الذي يضطرم داخله ويشلّ قدرته على العمل.
وقد اعتبر فرويد الأدباء أقدر على تحليل نفسيات شخوصهم عن علماء النفس في عياداتهم، فقال:"إن الشعراء والقصاصين يعرفون أشياء كثيرة ما تزال حكمتنا المدرسية قاصرة عن فهمها. إنهم أساتذتنا في إدراك النفس".
لكن أتباع (فرويد) تطرفوا في تفسير الأعمال الإبداعية، فذهب (إدلر) إلى أن الإبداع هو تعويض عن (عقدة النقص) التي يعاني منها المبدع. وقسم (يونغ) اللاشعور إلى نوعين: لا شعور شخصي ولا شعور جمعي. وإذا كان (فرويد) قد ركز على اللاشعور الشخصي ومكبوتاته، فإن تلميذه (يونغ) ركز على اللاشعور الجمعي المتوارث، والذي هو واحد عند جميع الناس. ومنه يستمد الأدباء والفنانون صورهم وأخيلتهم. وعلى أساسه نشأ (النقد الأسطوري) الذي يُعنى بالنماذج الأساسية: كنموذج الولادة الجديدة، والبعث.... الخ.
وعلى الرغم من أن النقد النفسي يبدو متطفلاً على الأدب، وإنه يحشر الأدباء في زمرة المرضى، وينسى حياتهم اليومية، فإنه أنار كثيراً من غوامض الإبداع والرموز التي كانت مستغلقة في وجوه النقاد.
ـ المنهج النفسي في النقد العربي:
يمكن القول إنه في نقدنا القديم (نظرات) نفسية (لا نظريات): فقد أشار إلى المحفّزات على قول الشعر: فقد روي أن عبد الملك بن مروان سأل أرطأة بن سهيّة: "أتقول الشعر اليوم؟ فقال: والله ما أطرب، ولا أغضب، ولا أرغب. وإنما يجيء الشعر عند إحداهن"(1). وهذه (البواعث) تثير التوترات النفسية التي تدفع إلى قول الشعر نجدها عند أكثر من شاعر: فدعبل بن علي الخزاعي يقول: "مَنْ أراد المديح فبالرغبة، ومَنْ أراد الهجاء فبالبغضاء، ومَنْ أراد التشبيب فبالشوق والعشق، ومَنْ أراد المعاتبة فبالاستبطاء"(2). وأبو تمام يوصي تلميذه البحتري بقوله: "اجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه، فإن الشهوة نعم المعين".(3).
ـ المنهج النفسي في النقد العربي الحديث:
في منتصف القرن العشرين، ونتيجة لمثاقفة نقادنا مع الغرب، أُثير الاهتمام بالمنهج النفسي في تفسير الأدب، فتبناه أمين الخولي، وحامد عبد القادر في كتابه (دراسات في علم النفس الأدبي)، ومحمد خلف الله في كتابه (من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده)1947، ومحمد النويهي في كتابه (ثقافة الناقد الأدبي) 1949 الذي حلل فيه شخصية ابن الرومي اعتماداً على بيولوجيته، وأرجع تشاؤمه إلى اختلال وظائفه العصبية والجسدية. ثم وضع كتابه (نفسية أبي نواس)1953 حلل فيه شخصية أ بي نواس اعتماداً على (عقدة أوديب)، التي اكتشفها (فرويد)، وعلى اللاشعور الجمعي الذي اكتشفه (يونغ). وعلّل إدمانه الخمرة بكونها تعويضاً عن مكبوتاته النفسية، وعن حنان أمه التي حرم منها منذ وقت مبكر من طفولته، حين تزوجت بعد وفاة أبيه، فأورثه هذا شذوذاً جنسياً يتمثل في النفور من النساء، بوصفهن ـ كأمه ـ خائنات. وقد دفع به نفوره من النساء إلى البحث عن (تعويض) فوجده في الغلمان حيناً، وفي الخمرة حيناً آخر. فتخيّل الخمرة أنثى، وخلع عليها صفات الأنوثة المغرية المثيرة التي يجدها الرجال العاديين في المرأة، ووصفها بالبكارة والعذرية، وسماها فتاة وبنتاً وجارية وعواناً، وأوهم نفسه أنه حين يمزّق دنّها فإنما يمزق غشاء البكارة عن عذراء.
كما اهتم عباس محمود العقاد بشخصيات الشعراء، فتتّبع سيرهم الذاتية، ورصد شخصياتهم، من أجل النفاذ إلى أسرار إبداعهم. فحلّل شخصية ابن الرومي في كتابه (ابن الرومي:حياته من شعره) 1963، درس فيه أصله، ونشأته، ومزاجه، وتكوينه النفسي والجسدي. وأرجع تشاؤمه إلى اختلال في أعصابه، وسخريته إلى خصائصه الجسدية. كما ردَّ عبقريته إلى أصوله اليونانية، وإلى الطيرة التي استحكمت به. ثم وضع كتابه (أبو نواس: دراسة في التحليل النفساني والنقد التاريخي) حلل فيه شخصية أبي نواس، وأظهر (عقده النرجسية) لديه، وعلى ضوئها فسّر مجونه، معتمداً على (فرويد) و(إدلر)، و(يونغ)، و(فروم). ورأى أنه كان جميلاً مفتوناً بمحاسنه، بسبب نقص غدد رجولته، وأنه لقي من أمه دلالاً زائداً بسبب شيخوختها، فاتخذها قدوة، مما وطّد له سبيل الانحراف عن الولع بالنساء إلى الولع بالرجال.
وتناول طه حسين شخصية (المتنبي) في نشأته، فرأى أنه كان يتستّر على معرفة أبيه وأمه ويتجاهلهما في الوقت الذي كان الناس فيه يتفاخرون بالأنساب. وأنه اتصل بالقرامطة لأنه كان مثلهم ثائراً على الأوضاع في بغداد. ثم تتبع حياته في بلاد سيف الدولة، فرأى أنه شغل نفسه بحركة الحياة الخصبة التي كان يحياها سيف الدولة، وأنه أظهر نفحة الحزن عند كافور عندما وجد نفسه سجين العناء والمرارة. كما درس طه حسين شخصية (المعري) فردّ ولعه بالتلاعب بالألفاظ إلى أنه عاش نصف قرن (رهين المحبسين): محبس البيت، ومحبس العمى. فطال عليه الزمن حتى ملَّه، فلجأ إلى قتل الوقت بالتلاعب بالألفاظ.
ودرس شوقي ضيف شخصية (عمر بن أبي ربيعة) فاستفاد من علم النفس، ووقف عند ظاهرة جديدة في الشعر العربي جاء بها عمر هي تحويل الغزل من المرأة إلى الرجل؛ فالمعهود هو أن يتغزل الرجل بالمرأة، لا العكس كما حدث مع عمر الذي أصبح هو المعشوق لا العاشق. وفسّر الناقد هذا التحول بأن عمر كفلته أمه بعد موت أبيه، فقامت على تربيته، وتعلقت به بوصفه وحيداً وجميلاً. وأغدقت عليه من فيض حنانها ودلالها. فانعكس ذلك إعجاباً بنفسه في شعره: فالنساء هن اللواتي يطلبنه، ويعشقنه، ويرغبن في وصله، بينما يختال هو عليهن، ويتأبى ويتمنّع إعجاباً بنفسه. وهذا الإعجاب الزائد بالنفس هو ما سماه علماء النفس بـ(النرجسية)(4).
ثم أصدر عز الدين اسماعيل كتابه (التفسير النفسي للأدب) عام 1963 عالج فيه عملية الإبداع الأدبي، فرآها وليدة اللاشعور، وأنها كالحلم، تتخذ من الرموز أو الصور النفسية ما ينفّس عن الرغبات. كما حلل نفسية المبدع، ورأى أنه قد يكون عصابياً، ولكنه ليس مجنوناً. وعصابه لا دخل له في قدرته على الإبداع، لأنه حين يبدع يكون في حالة جيدة من الصحة النفسية، كما أنه ليس نرجسياً، لأنه حين يبدع يعوّض بإبداعه الأدبي عن نرجسيته.
ثم نشر خريستو نجم كتاب (النرجسية في أدب نزار قباني) عام 1983 قرأ فيه شعر نزار على ضوء (عقدة النرجسية) في التحليل النفسي. وهي عقدة مرضية تبتدئ في طفولة كل طفل، حيث يمر بالمراحل الثلاث: الفمية، والشرجية، والقضيبية. وقد تتبع الباحث تطور هذه المراحل في حياة نزار، واعتبر انتحار أخته إسهاماً في تسامي مشاعر الشاعر السلبية. فغدا الشاعر أنثوي الإحساس، يعبّر عن مشاعر المرأة الرقيقة.
ولكن عقدة (النرجسية) تنزاح عند الباحث ليجعل من الشاعر انطوائياً! وسادياً! ومازوشياً! وأوديبيا! ودون جواناً! مسلّطاً على شخصية نزار كل هذه العقد النفسية. كما تجاوز الناقد الأخذ من فرويد ليأخذ من معظم المدارس النفسية.
لكن المآخذ على النقد النفسي تتمثل في أن ممارسيه، هم في الأغلب، علماء وأطباء لا أدباء أو نقاداً. وقد اتخذوا الأدب وسيلة لخدمة ميدانهم المعرفي، وليس لخدمة الأدب أو النقد. وقد اعترف (فرويد) بذلك حين قال: "إن التحليل النفسي لا يستطيع أن يدرس الإنسان من حيث هو فنان، ولا أن يطلعنا على طبيعة الإنتاج الفني"(5). كما اعترف (يونغ) بذلك فقال: "إن المنهج الذي يمكن الوصول عن طريقه إلى حقيقة الفن لابد أن يكون منهجاً فنياً"(6).
كما أن النقاد النفسيين اهتموا بشخصية ا لأديب على حساب أدبه، وتسرّعوا في استخلاص النتائج دون التمثل الجيد لمقولات علم النفس: فالعقاد يرسم لابن الرومي صورة جسمانية تفضي إلى صورة نفسية. والنويهي يمهد لبحثه بمقدمة طويلة في علم وظائف الغدد والأعضاء قبل أن يدخل "فأر التجارب" ابن الرومي إلى المختبر، ثم يعزله عن عصره، وبيئته، ومجتمعه لينتهي إلى تفسير عبقريته بمرضه العقلي، وبعقدة الفشل الناجمة عن عدم تحقيق رغباته التي تتعارض مع الواقع. مما دفع الشاعر إلى التعويض، حسب (فرويد). وهكذا نجد أن سلطة الكاتب (أو المؤلف أو المبدع) التي أعلت المدرسة النفسية والرومانسية من شأنها، قد وصلت إلى ذروة الاهتمام بها لديهما. ولكن الانحسار سيأتي لاحقاً، حيث سيتحول الاهتمام إلى (النص) الأدبي.
ْ
________*التــَّـوْقـْـيـعُ*_________
لا أحد يظن أن العظماء تعساء إلا العظماء أنفسهم. إدوارد ينج: شاعر إنجليزي