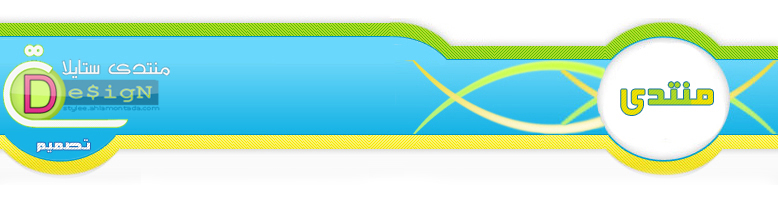تحرير العقل الإسلامي
عرض: عبد السلام طويل
مقدمة:
صدر عن المركز الثقافي العربي الدار البيضاء/ بيروت كتاب " تحرير العقل الإسلامي"، لصاحبه قاسم شعيب في طبعته الأولى 2007، وهو كتاب من القطع المتوسط عدد صفحاته 206، وينقسم إلى مقدمة ومدخل وستة فصول؛ المدخل تناول : "العقل الإسلامي.. هموم التحرير والتنوير"، والفصل الأول جاء بعنوان "النص القرآني.. واستراتيجيات القراءة"، والفصل الثاني"خارج الحداثة.. صدام السلفية والعلمانية"، والفصل الثالث"ضلال الإيديولوجيا"، والفصل الرابع "الإسلام وتحولات الواقع" أما الفصل الخامس فقد انصب على "إنسانوية الإسلام" في حين جاء الفصل السادس موسوما: "ضد هيغل.. جبر التاريخ أم فاعلية الإنسان. "ولتقريب القارئ الكريم من مضامين هذا الكتاب، سنحاول طرح أهم أفكاره وقضاياه..
أولا: في مغزى تحرير العقل الإسلامي
ولعل أنسب ما نستأنف به هذا العرض إجراء قراءة دلالية في عنوانه من شأنها أن تقربنا من مقصد مؤلفه. فـعنوان الكتاب: "تحرير العقل الإسلامي" يستبطن، كما هو جلي، دعوة لتحرير هذا العقل من جملة القيود والأوهام والحجب والمغالطات والتقاليد.. التي تحول دون فاعليته وإبداعه واستجابته واستيعابه لمقاصد النص وفلسفة التاريخ، والجدل القائم بينهما..
يستهل الكاتب مؤلفه بقوله: "لم يكن العقل الإسلامي في حاجة إلى التحرر من قيود التاريخ وعصبيات المجتمع، وزيف السياسة وفساد الواقع كما هي حاجته اليوم."(ص 5 )، وفي سياق تأسيسه للحديث عن تحرير العقل الإسلامي، يقف الكاتب على مفهومي الاختلاف والعقل؛ مؤكدا أن الاختلاف حقيقة يقرها الإسلام وأن "التماهي لا يعني شيئا غير الجمود والخراب والعدمية. "كما أن العقل" يبقى أساس الإيمان والصلاح، والفعل والإنجاز، والإبداع والامتياز. أما الإعراض عنه فلا ينتج إلا القلق والفساد.." ( ص 7) ومن هنا جاءت دعوة الكاتب إلى أن يأخذ العقل دوره المركزي لا فقط في تعاملنا مع ثقافة الآخر، أو نصوص التراث، بل أيضا في تعاملنا مع النصوص الإسلامية التأسيسية، كتابا وسنة. استجابة لنداء القرآن الكريم الذي لا يكف عن توجيه الخطاب للمسلمين:
"أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا يتفكرون، أفلا تذكرون، أفلا تنظرون.. وهو ما يوحي أن العقل يمثل مرجعية حتى بالنسبة للقرآن نفسه." ( ص 14)
إن انتصار الكاتب للعقل أفضى به إلى انتقاد النزعة النصية كاشفا "أن الحقيقة التي يغفلها النصيون هي أن القرآن لم يأت بديلا عن العقل بقدر ما جاء هاديا له ومرشدا" وتفسير ذلك أن "مثل العقل والقرآن كمثل البصر والضياء فلا العين يمكنها أن تبصر دون ضياء، ولا الضياء قادر على أن يجعل الأعمى بصيرا." وهذا يعني أن العقل والنص يتكاملان خدمة الإنسان؛ بحيث أن التضحية بأحدهما سوف لن ينتج عنها إلا التضحية بهما معا.
وفي نفس المنحى، يؤكد المؤلف أن الثقافة المناهضة للعقل والرافضة للاختلاف هي "ثقافة الخوف" التي "لا تسمع إلا صوتها ولا ترى إلا صورتها. وهي ثقافة لا تنتج إلا مزيدا من العصبيات المذهبية والحزبية والطائفية. "كما أنها ثقافة" لا تكرس إلا ألوانا من الانعزالية والخيانة والنفاق والخمول.. فالجميع يخاف من الجميع.. فلا ثقة ولا تعاون ولا وضوح. "الأمر الذي يترتب عليه ضمور بل غياب "الروح الجماعية" التي تعد شرطا لأي فعل مدني وتراكم حضاري.
ولذلك، فإن مواجهة هذه الثقافة لن يتأتى، إلا بتحرير العقل الإسلامي من خلال "نقد كل مسلماته وبديهياته التاريخية ليصبح كل شيء قابلا للنقد وإعادة النظر."( ص: 9)
ثانيا: في ضرورة النقد
الملاحظ أن مفهوم النقد يحتل مكانة مركزية في البناء المعرفي لهذا الكتاب؛ فالنقد بالنسبة للكاتب " عودة إلى العقل للاهتداء بهديه من أجل مراجعة ما يبدو ثوابت، وتعرية ما يبدو بداهات، إنه تفكيك لقوالب صنعها غيرنا، وأصبحت مع الزمن قواعد لا يجوز الاقتراب منها." ومن ثمة تحذيره من أن تنغلق العقلانية الإسلامية " على نفسها في مساحة ضيقة هي التجربة الإسلامية، أو آراء الأقدمين، أو الفهم الحرفي والمتحجر للنص. "ودعوته في المقابل إلى أن يصطبغ العقل الإسلامي" بالمرونة التي لا تهمل الواقع، وتنطلق من النص الذي لا يصادر على العقل بقدر ما ينير له الزوايا المعتمة.. دون أن ينسينا ذلك تلكؤ العقل في بعض الأحيان.. بحيث يتحول إلى أداة لطمس ما هو ضروري للوجود الإنساني ضرورة العقل نفسه."( ص 15)
غير أن احتفاء الكاتب بالعقل لم يحل دون نقده له من منطلق أنه يمكن أن يستخدم في حالات كثيرة كأداة من أجل بلوغ غايات وأهداف مناقضة للعقل والعقلانية.( ص 14)، وكما هو معلوم فإن كل التراث النقدي لتيار ما بعد الحداثة انصب على نقد العقلانية الغربية حينما " تحولت إلى أداة لمراكمة رأس المال، واحتكار السلطة، وإقصاء الأخلاق، وإشباع النزوات." وارتد العقل إلى اللاعقل والتنوير إلى جاهلية.. ومن هنا تنبع أهمية وحيوية الركون إلى العقل المستنير بهدي الوحي؛ إذ سرعا ما اتضح في سياق التجربة الحضارية الغربية أن "العقل وحده لا يمكنه أن ينتج نظاما أخلاقيا عمليا يدفع الإنسان بشكل ذاتي إلى احترام القيم الإنسانية العليا. بل لا بد من وجود العامل الديني كحافز أو كرادع من أجل أن تتحول الأخلاق من مجرد نظام نظري مجرد كما أسس لها كانط مثلا، إلى ممارسة عملية ذاتية نزيهة كما أسس لها الإسلام."( ص 18).
ثالثا: الإجتهاد بين النص والتاريخ
ومن القضايا الهامة التي أثارها الكتاب ما يمكن التعبير عنه بقضية الاجتهاد بين النص والتاريخ؛ حيث شدد الكاتب على أن معرفة الواقع والإحاطة به من الشروط الأساسية لنجاح العمل الفقهي "لأن الانزواء عن المجتمع والواقع وممارسة العمل الفقهي بعيدا عن هموم الناس لا يمكن أن يكون إلا تكرارا لآراء القدامى الذين كانوا يتعاملون مع واقعهم." وبالمقابل فإن التعامل مع الواقع يجب ألا يتم على أساس الرأي والذوق والثقافة السائدة "دون الرجوع إلى النصوص القرآنية والحديثية لاستنطاقها والاسترشاد بها." لأن من شأن ذلك أن يشكل خطرا كبيرا على حركة الأمة. ولذلك نجد الكاتب يؤكد، في أكثر من سياق، على الحاجة إلى مقاييس ومعايير مفارقة وسامية تتعالى عن الواقع حتى تكون قادرة على تطويره نحو الأفضل.
وفي هذا الإطار يبرز الكاتب أن الفقيه مطالب بالقيام بحركتين" الأولى من الواقع إلى النص؛ بحيث لا بد له من الإحاطة بمشاكل الواقع ثم طرح هذه المشاكل أمام النص من أجل استنطاقه في شأنها، والحركة الثانية من النص إلى الواقع حيث يتبلور الرأي الفقهي في ذهن الفقيه، ثم البحث في وسائل تطبيق الفتوى وكيفية تفاعل المكلفين معها أفرادا ومؤسسات" كما ينبه إلى عدم الخلط بين تكليف الفرد وتكليف الأمة.
وفي كل الأحوال فإن الكاتب يعطي الأولوية للنص على الواقع..( ص-ص: 26-27) وهي الأولوية التي تبرز بمناسبة تناول الباحث لمسألة قراءة النص القرآني؛ وانتقاده لمختلف المناهج والقراءات التي لا تحترم خصوصيته الإلهية سواء تعلق الأمر بالمنهج التفكيكي الذي يفضي إلى " نفي القصدية عن النص القرآني والإدعاء بعبثيته." علما أن "خطورة إخضاع النص القرآني لإستراتيجية التفكيك، هي الانتهاء إلى الادعاء بأن الإسلام لم يكن إلا ثمرة مستفادة من ثقافة عصره والديانات السابقة عليه.." ."( ص: 35) أوالسعي إلى "إخضاع القرآن لمحك النقد التاريخي المقارن." كما نجد لدى محمد أركون الذي انتقد الكاتب المنحى المنهجي الذي اعتمده لقراءة القرآن الكريم.( ص: 33)
ومع أن الكاتب لا يعترض على إمكانية أن يكون القرآن في بعض تشريعاته مستجيبا لمعطيات عصره من قبيل قضايا العبيد والإماء.. إلا أن ذلك "لا يمكن أن ينسحب على العقائد التي أسس لها والقيم التي دعا إليها، لأن هذه العقائد في معظمها معطيات غيبية لا يمكن للعقل أن يعطي بشأنها أية أحكام.." كما أن القرآن رغم صلته القوية بالواقع التاريخي الذي نزل فيه إلا أنه كان دوما مهيمنا على هذا الواقع بغرض إصلاحه وتغييره وتطويره."( ص-ص: 35-36).
وبعد أن ينتقد الباحث المنهج التفكيكي والتجزيئي والموضوعي يقترح ما سماه بـ"التفسير القيمي" الذي يستبعد عبثية النص، ولا يعترض على تعدد القراءات، ويميز بين الثابت والمتحول ضمن بنية النص..( ص-ص: 61-63)
رابعا: التجديد وسؤال الهوية
بعد ذلك عمل الكاتب على تحديد مفهوم الحداثة وإبراز تاريخيتها مؤكدا على خصوصية مشروع النهوض الحضاري للأمة بناء على تصور تاريخي تطوري للهوية كسعي دائم للذات بغرض تحققها في التاريخ . حيث انتقل من تاريخية الحداثة لإبراز الفروق بينها وبين تاريخية الإسلام ."( ص: 126) داعيا إلى تجديد علم الأصول كإطار علمي منهجي ضابط لعملية الاجتهاد.( ص: 141)
وفي سياق نقده لمقاربة محمد أركون اعتبر أن سؤال من أين نبدأ من الإسلام أم من الحداثة؟ سؤال خاطئ جوهريا، مؤكدا أن البداية لا بد أن تنطلق من الذات من أجل تمحيصها، مع ضرورة مراعاة قابليات هذه الذات وما ينسجم مع خصوصياتها وثوابتها من خلال "استبعاد كل مكونات الحداثة الغربية في جوانبها السلبية المناقضة للأخلاقيات والقيم الإسلامية، وفي أفكارها المادية المعادية للدين والمناقضة بطبيعتها للروح الإسلامية العامة. "داعيا بالمقابل إلى الانطلاق من الذات سعيا لنقدها في شتى جوانبها السلبية ثم البحث في عمليات الإفادة من الحداثة الغربية في قيمها وإبداعاتها على قاعدة المفاهيم والقيم الإسلامية التي يجب أن تقرأ هذه المرة على أساس المقاصد العامة للإسلام وتوجهاته الإنسانية الكونية.( ص-ص: 89-90)
غير أن حديث الكاتب عن ثوابت الذات لا يعني أنه ينظر إلى الذاتية أو الهوية كشيء ناجز ومكتمل،وإنما ينظر إليها باعتبارها "مشروعا ينجزه الإنسان في ذاته ومجتمعه" و"محاولة لإبداع الجديد المثمر، وخروج عن قوالب تشكلت بفعل التاريخ وتحولت إلى مقدسات. "فالهوية بهذا المعنى "انطلاق من الواقع من أجل إعادة تشكيله بالصورة التي يطمح إليها الإنسان وبالكيفية التي تجعله أكثر انتفاعا بإمكاناته الإبداعية." كما أنها "لا يمكن أن توجد إلا مع الاختلاف، ولا يوجد الاختلاف إلا بوجود الحركة في الفكر والتكامل في العمل بما يعنيه ذلك من مراجعة نقدية لا تتوقف." وانسجاما مع ذلك، ينفي الكاتب أن يكون لأفراد المجتمع أية هوية إنسانية سابقة على وجودهم الاجتماعي؛ من منطلق أن "الإنسان لا يكون إنسانا إلا في ظل الروح الجماعية"( ص: 158)
غير أن انطلاق الكاتب من كون الهوية مشروعا ينجز في خضم التاريخ،" لا يعني التخلي عن القيم الإنسانية المتعالية التي تأبى الخضوع للتاريخ أو الجغرافيا، فهي أكبر من القومية وأوسع من الجغرافيا."كما أن مثل القيم " تتعالى على التاريخ لتبقى هدفا للإنسانية الخالدة، ولذلك فإن الكثير من القيم التي تنسب إلى الحداثة الغربية كالعلم والعمل والعدالة والحريات والحقوق، إنما هي في الحقيقة قيم عالمية لم تكن غائبة عن ذهن الإنسان في أي مكان و أي زمان."( ص: 92)
إن هذا المفهوم التاريخي للهوية يصدر عن تصور للإنسان من منطلق كونه ذاتا فاعلة في التاريخ تبدع وتنتج على هدى منظومة من القيم . وفي هذا السياق يكشف الكاتب كيف أن "الإنسان عندما يتحول من كائن مفكر إلى كائن مسلم يعطل في ذاته طاقاته العقلية وقدراته الذهنية، ويصبح مجرد مقلد." كما يبرز أنه حينما يكون الواقع متحركا باستمرار، فإن ذلك يستدعي جهدا مستمرا من أجل ملاحقة تغيراته، وبحثا متواصلا عن أفكار جديدة قادرة على التفاعل معه لتبقى الفكرة العميقة هي الفكرة الأقدر على التعامل الإيجابي الخلاق مع الواقع." وانسجاما مع هذا التصور، يرجع الكاتب النجاح الباهر للرسول صلى الله عليه وسلم "إلى قراءته العلمية الصحيحة لواقعه" وعدم انطلاقه من أفكار ناجزة يمعن في إسقاطها على هذا الواقع. وهو ما يفسر أنه (ص) كان كثير الاستشارة لأصحابه شديد الاحترام لآرائهم.( ص: 107)
ولتأكيد وعي الإسلام بالشرط التاريخي، يبرز الكاتب كيف أن إيمان الإسلام بالحرية والمساواة في الإنسانية لم يترتب عليه التزامه الفوري بتحرير العبيد دفعة واحدة بقدر ما عمل على "فتح الأبواب لتحريرهم، وأغلقها عن استبعاد الأحرار فشجع بطرق شتى تحرير العبيد وحرم استعباد الأحرار"إذ لو حاول الإسلام تطبيق أفكاره في الحرية والمساواة مرة واحدة لمني بفشل ذريع". لأن الإنسان "قد يرفض نظاما من العدالة الصارمة ويرى أن بعض الظلم عدل، وفي حالة كهذه لا يمكن إلا ممارسة العدالة في شكل جرعات."( ص: 109)
خامسا: الوعي التاريخي والأخلاق
يخصص الكاتب حيزا مهما من الفصل الخامس من كتابه لنقد الحتمية التاريخية وتأكيد الفاعلية الإنسانية مبرزا أن "الإنسان عندما يكتشف القوانين التي تحرك التاريخ من خلال علم التاريخ وفلسفته، ويتمكن من معرفة العوامل التاريخية التي تؤثر في صياغة فكر الإنسان ومشاعره وقيمه، يمكنه بذلك كله أن يحطم سجن التاريخ ويصنع بنفسه هذا التاريخ." وتبعا ذلك، يستنتج أن " مسيرة التاريخ ليست خطية مرسومة بشكل مسبق دون استشارة الإنسان، بل إن الإنسان هو من يرسم خط التاريخ سموا وانحطاطا."( ص: 157) وتأكيدا للإرادة الإنسانية ضد كل الحتميات يذهب إلى أن "الإنسان إذا ملك وعيه وإرادته كان قادرا على تحطيم أي سجن وكسر أية جبرية."( ص: 159)
ومن جهة أخرى، يبرز الكاتب كيف أن الإرادة الإنسانية الهادفة لا يمكن تصورها بدون الأخلاق؛ معتبرا انه من قبيل البداهة أن الإنسان بلا أخلاق يعد إنسانا عنيفا فاسدا ومستبدا "لأن الأخلاق هي وحدها التي تعطي الإنسان الإرادة التي يتمكن بها من التحكم في أهوائه ورغباته وإنصاف الآخرين." كما أن الأخلاق المؤسسة على الإيمان الصحيح هي التي تمنع من انحدار الإنسان إلى وهدة الانحطاط " لأن الدين التوحيدي.. هو ما يمنح الإنسان محبة الآخرين، والتضحية من أجلهم، وخدمة مصالحهم." كما أوضح الباحث كيف أن الإسلام قد استطاع أن يفعل ذلك من خلال توسيعه لمفهوم المصلحة التي لم تعد تقتصر على المصلحة المادية الدنيوية، ولا حتى المصلحة المعنوية، القائمة على احترام الآخرين للذات الإنسانية واعترافهم بها، وإنما أمست تتعداهما ّإلى المصلحة الأخروية التي تتصاغر أمامها أية مصلحة.. ( ص-ص:162-161)...
وفي ختام مؤلفه، الغني بالقضايا والأفكار التي قد نتفق مع بعضها كما نختلف حتما مع بعضها الآخر يعمل الأستاذ قاسم شعيب على تكثيف أهم عوامل ومقومات النهضة في تفاعل مجموعة من العناصر التي أجملها في "الناس، والقيادة، ومعرفة قوانين التغيير، ووجود القيم المنشودة." .( ص: 197)
ْ
________*التــَّـوْقـْـيـعُ*_________
لا أحد يظن أن العظماء تعساء إلا العظماء أنفسهم. إدوارد ينج: شاعر إنجليزي