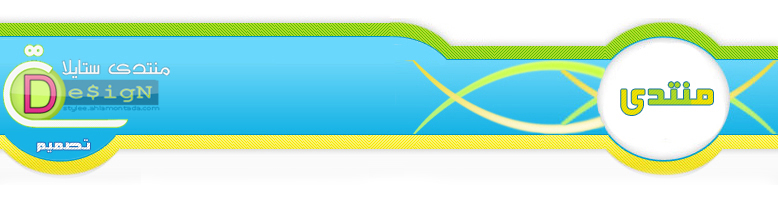مما هو صادق في ذهني أن وليم شكسبير (1616-1564) هو فيلسوف بقدر ماهو شاعر وكاتب مسرحي وخبير باللغة الإنجليزية التي وظف عشرين ألف جذر من جذورها في تراثه الواسع، أي أربعة أخماس المفردات التي تؤلف المعجمن الانجليزي. وتتلخص فلسفته في أن الحياة الم أو مأساة وأن الأنسان شرير إلا من عصم ربك. ولهذا فإنك تراه حساساً ضد الشر إلى الجد الذي جعله يقترب من الإيمان بوجوب اجتثاث الحياة. وهذا يعني أنه، بالدرجة الأولى، فيلسوف أخلاقي، وأن مسرحياته، أو معظمها، هي صراع بين القوى الخيَّرة والقوى الشريرة ذات اللون المالح.
ولدى العودة إلى الكتاب المنقطع النظير في بابه، والذي نثرته كارولين سبيرجن سنة 1935، أعني « المجاز عند شكسبير » فإننا سوف نتعرف على فلسفته الإنسانية النفسية والبسيطة في آن واحد. ففي نظره، كما بينت تلك الناقدة النادرة، أن الإنسان الطيب هو كائن من أجل الاخرين. أن نصادق البشر، أن ندعمهم، أن نساعدهم، أن نبهجهم وأن ننيرهم بانوار العقل والفكر الصحيح، ذاك هو الموضوع الجوهري والكلي لوجودنا أو لكينونتنا الحية. ولئن أخفقنا في هذا المسعى، أو قصرنا في إنجاز هذا الهدف، فإننا لن نكون سوى قشور خاوية، أو كائنات جوفاء تفتقر إلى كل قيمة أو فحوى.
يقول شيكسبي في مسرحية له عنوانها « دقة بدقة » : « لم تسوَّ أرواحنا على نحو رائع إلا من أجل أغراض رائعة » وما من غرض رائع أو نبيل في نظر شكسبير أبعد من الاهتمام بإنسانية الإنسان. فالمهم عنده هو كيف نحيا الحياة بحيث نعامل أبناء جلدتنا من البشر بوصفهم غايات موجودة لذاتها، وليسوا وسائل إلى غايات يبتغيها الشر ويكد منهم من أجل تحقيقها.
وتضيف تلك الكاتبة الموهوبة ما فحواه أن ثالوث شكسبير هو الحب والحنان والرحمة. أما أعظم الشرور عنده فهو الخوف الذي من شأنه أن يطرد الحب وينفيه. وأما مايثير غضبه أكثر من سواه فهو الظلم، أولاً، والنفاق، ثانياً. وما من شيء يجعل شكسبير يمتعض ويستاء اكثر من الخوف الذي يراه تدميراً لشخصية الإنسان. ومما لايخفى أن الحب والحنان والرحمة، وكذلك اللطف الذي يبجله شكسبير أيما تبجيل، هي صفات إنسانية متمدة من لباب المسيحية بالضبط.
وعندي أن من واجب الذهن النقدي ألا ينظر إلى شكسبير بوصفه داعية أخلاق بالدرجة الأولى، وذلك لأن اعظم ما فيه هو رؤيته للمأساة الكونية الشاملة، أو شدة سعوره بالكارث والفاجع، وكذلك تلمسه للهول المريع الرابص في صميم الحياة البشرية. ولامراء في أن هذه الرؤيا لا يتيسر انتحالها بتاتاً، بل هي لاتعنو قط لأي تعلم أو تعليم. فإما أن يولد المرء محروماً منها أو مزوداً بها، ولا شيء سوى ذلك ومع أن شكسبير قد انتفع بألف مصدر ومصدر (شأنه في هذا شان دانتي)، فإن شعوره المأسوي العميق هو العنصر الأول في تفرده وبنية شخصيته. أما العنصر الثاني فهو القدرة على التصوير وإحالة الأفكار أو المعاني إلى مجازات، وكذلك قدرته على التماهي مع اللغة إلى الحد الذي لايضاهيه، بل لايدانيه، أحد.
ولعل مما هو ناصع تمام النصوع أن الأخلاق الخيَّرة التي يتبناها ذلك الكاتب هي الأخلاق المسيحية نفسها. ويلوح أن أصالة النظرة الأخلاقية التي تؤلف شطراً كبيراً من قوامه هي جذر متين بين الجذور التي مكنته من بناء شخصيات لاتنسى. ومما هو من المسلمات عند النقاد الغربيبن أن عظمة شكسبير تتأسى على عدة ركائز شديدة الصلادة، ومن بينها هذه القدرة على بناء الشخصيات الاستثنائية ذات الحضور القوي.
ولكن الأمر الذي لايجوز إغفاله حين يكون المرء في هذا الصدد هو أن المسيحية نفسها ديانة مأسوية، أو يتالف صميمها من مأساة، وذلك على غرار ديانات الخصب الوثنية، ولاسيما ديانة تموز وأوزير وأدونيس، التي هي عقائد موت الإله وفقاً لمذاهب أتباعها.ولكن المسيحية تبذ تلك الديان من جهة الشعور المأسوي، وذلك لأن المقتول هنا ( وفقاً للأناجيل ) هو شاب يجسد الطيبة واللطف، والأهم من ذلك أنه ماصلب على أيدي الأشرار إلا من أجل إفتداء الإنسان، بينما قتل تموز أو أدونيس أو أوزير من أجل لاشيء. وهذا يعني أن المسيحية أكثر نبلاً من تلك الديانات الوثنية التي تشبهها. ولهذا، فغن قارىء شكسبير يملك أن يلاحظ النبل في شخصياته التي تهوى وهي تكافح ضد الشر والأشرار دون أي خوف أو دون أية هوادة.
ثم إن الفرق ناصع بين مسرح شكسبير والمسرح اليوناني. فقد جاء مسرح ذلك الانجليزي الفذ ارقى من المسرح الكلاسيكي لأنه هو خلاصة لتطور طويل في ثقافة مصر والشام والعراق، أو ثقافة منطقتنا التي لم يكن بناء الأهرام، أو برج بابل السابق الباذخ، سوى غنجاز واحد من انجازاتها التي لاتحصى.
وآمل أن اكون خليف السداد إذا ما زعمت بأن المأساة الإغريقية بطيئة الحركة والصراع فيها كثيراً مايكون فاتراً أو فقيراً إلى الحرارة الكافية، بينما يخلق شكسبير عاصفة جامحة يحملها الفعل الدرامي المتوتر والمتصاعد باستمرار صوب المصير النهائي للمسيرة الدرامية بأسرها. وهذا يعني ان شكسبير اعمق من أي كاتب مسرحي إغريقي، وأكثر قدرة على تحري الحياة، وكذلك على تخريج الانفعالات أوبتها في شكل فني مخضب باليخضور او بالحيوية الدافقة.
ويلوح لي أن ذلك الكاتب، وهو يمعن في التنقيب عن كنه النفس والحياة البشرية، إنما يمعن في التمتع، وكذلك في جعلنا نغوص في المتعة، مع أن الحقائق لاتنطوي إلا على الكارث في صميمها المكنون. وهذا هو جدول اللذة والألم الذي تضمره المأساة، والذي لا أحسب أن أرسطو قد عثر عليه في أي يوم من الأيام. نحن نتلذذ بآلامنا. هذه هي خلاصة الاقتراب من شكسبير. وهذا صنف من أصناف اللذة قد توفره لنا سوى المأساة واديان الخصب، وذلك لأنها تأخذنا إلى أعماقنا السحيقة، أو إلى قرارة النفس التي هي ماهية واحدة لدى جميع البشر ( أعني القرارة ). وربما كان ميلنا المكتوم إلى التلذذ بآلامنا رئيس الأسباب التي أدت على انتشار المسيحية على نحو نادر في التاريخ.
ويما أن الصراع شديد العرام في مسرح شكسبير فقد راح ذلك المسرح يتألف من مثنويات متجادلة على نحو حاد : جدل الداخل والخارج، جدل الذات والموضوع، جدل النفس وبيئتها التي تتحكم بها وبمصيرها على نحو حاسم. إنه التضاد المانوي وهو يتجلى في أزخم أصنافه المألوفة طوال التاريخ. وهذا واحد من الأسباب التي مكنت مسرح شكسبير من أن يتفوق على المسرح الإغريقي، بل على أي مسرح آخر في أي زمان ومكان.
وبسبب من صدوره عن التضاد العميق بين الخير والشرن عن التضاد العميق بين الخير والشر، وهو ما يؤلف صميم الديانة المسيحية، فقد جاءت نظرته المأسوية إلى الحياة مختلفة أشد الاختلاف عن نظرة سوفوكليس في مسرحية « أوديب ملكاً »، التي أراها ذروة المسرح الكلاسيكي كله، وواحدة من أعظم المسرحيات التي كتبها الجنس البشري باسره. ففي هذه المسرحية الأخيرة، التي قد تكون شرقية المصدر، ينشأ المأسوي عن قدر غيبي خلق ظروفاً حتمت الفاجع أو السقوط النهائي، أو جعلته حادثاً إجبارياً لاتجدي فيه إرادة الأنسان.
بيد أن شكسبير لايقيم أيما وزن للقدر الغيبي، بل يرى مصدر الشر والمأساة في جوف الإنسان، أو في صلب النفس قبل سواه. وهذا مذهب أتاه من صميم المذهب البروتستانتي الذي عمّق الحياة الباطنية وجعل الأولوية للداخل لا للخارج. ولهذا أراني أعتقد بأن شكسبير يتعذر فهمه على نحو جيد بمعزل عن رؤية العناصر البروتستانتية التي تؤسس الشطر المأسوي من مسرحياته الخالدة. فهاهو ذا يقول في مسرحية « يوليس قيصر » : « ليس العيب في طالعنا، يا بروتس، إنما العيب في أنفسنا. » (140،2،1).
ومن الضروري أن أنوه في هذا الموضع بان عمق الرؤية المأسوية في مسرح شكسبير قد نتج عنه بصورة تلقائية أن جاء الأسلوب اللغوي ناضجاً على حد غير مسبوق في تاريخ المسرح، بل في تاريخ الآداب كلها. فلا مرية في أن ثمة اختلافاً كبيراً بين أسلوب شكسبير ذي الماهية الشاعرية بامتياز، أو الطافح بالحيويية على نحو استثنائي، والذي يسعك أن تنعته بانه جليل وجميل ورصين في آن واحد، وبين أساليب المسرح اليوناني ذات الطابع النثري، أو الذي لايتمتع إلا بالقليل من الانزياح الشعري أو من الخيال التصويري الصانع للمزية الفنية.
ففي الحق أن شكسبير خليل اللغة، وأن اللغة سميرة شكسبير ومؤنسته، والتعويض الذي يناله عما يكابده من الم واغتراب ولاغلو إذا مازعمت بان له عليها سلطة كسلطة الملوك على رعاياهم. ومع ذلك، فإن قارىء شكسبير، قد يشعر بأن اللغة لاتتسع لما في سريرته من محتوى شعوري فياض، على الرغم من أنه قد وظف أكبر حشد ممكن من جذور اللغة الانجليزية. وهذا يعني أن سبب ضيق اللغة هو الزخم أو الدفق الغزير الذي يتمتع به وجدان ذلك الشاعر المنكب بغزارة على ماهية الحياة ابتغاء تصويرها أو عرضها داخل شكل ادبي حي. ومما هو لافت للانتباه أن سبيرحن لم تبين لنا لماذا كان أسلوب شكسبير أخاذاً فاتناً، أو ماهي السمات المبتوته في لغته والتي أضفت عليها المتانة والجلال، بل القدرة على الخلب في كثير من الأحيان، دون أن يسرف في التخيل كما أسرف غوته طوال الجزء الثاني من مسرحية « فاوست ».
في مسرحية « هاملت أمير الدنمرك »، تمة مفارقة حادة لابدلها من أن تلفت انتباه المتأني، ومع ذلك فإنني لاأعرف من ذكرها بتاتاً. فمن الجهة الأولى، يتواتر فيها ذكر الضمير عدة مرات، بل يسعك القول بأن بطلها هو الضمير حصراً، أو هاملت الذي جسد الضمير على خير وجه ممكن. وما هاملت في هذه المسرحية إلا شكسبير نفسه. فحتى حين تسبب ذلك الشاب الراقص لما هو قائم بإعدام كل من روزنكرانتس وغُلدنستيرون، فغنه قد فعل ذلك بوحي من ضميره الحي النقي، واستجاية لغريزة العدالة التي هي لب محتويات الضمير فالرجلان منافقان فاسدان يستحقان الإعدام جزماً. فلئن كان « الشرف » هو الكلمة المفتاحية في مسرحية « عطيل »، كما بين وليم امبسن ذات مرة، فغن الضمير هو الكلمة المفتاحية التي من شأنها أن تفتح جميع التفاصيل في مسرحية « هاملت » بكل نصوع.
ومن الجهة الثانية، تتواتر كلمة « مومس » عدداً من المرات لافتاً للانتباه، بحيث لايفوت اللبيب مافحواه أن ذلك التواتر ليس بغير دلالة بنيوية ناصعة. كما تتواتر الإشارات التي تؤشر إلى الفعل الجنسي على نحو مقصود، ولكن بطريقة لاتخلو من البذاء أحياناً، وربما جاز للمرء أن ينعتها بانها إشارات غوغائية دون أن يخرج عن جادة الصواب ولايب عندي في أن ذلك الكاتب لم يقصد تلك الإشارات لذاتها، أو لتهييج الغريزة الجنسية عند القارىء، أي ليس هنالك من غاية إباحية، أو بورنوغرافية، بتاتاً وكل مافي الأمر أن شكسبير قد وضع البذاء، أو الإشارة الجنسية، في مواجهة النقاء، أو في مواجهة الضمير نفسه، كما وضع شيئاً من الإشارات التي تؤشر إلى المرض في مواجهة الصحة والسواء. فهناك بيت يقول : « تمة شيء ما متعفن في دولة الدنمرك » (90،4،1) وفي صلب الحق أن شكسبير، مثل ماني، لايرى إلا بنية تتركب من أضداد أو متناقضات والآن، ما دلالة هذه المفارقة ؟ .
قد لا أجافي السداد إذا مازعمت بأن بان تواتر كلمة « المومس » في المسرحية وغياب كلمة « الزواج »، وهي المشرة إلأى نقاء الصلة بين الذكر والأنثى وفقاً للأعراف المرعية، وكذلك حضور الإشارات الجنسية الخادشة للحياء، وغياب الحب الذي هو أنبل وأصفى علاقة بين الرجل والمرأة، إن من شأن هذا كله أن يؤشر إلى مافحواه المدنس قد حل محل المقدّس في البيئة الاجتماعية التي تحيط بجو الحدث المسرحي كله ومن الواضح تماماً أن شكسبير قد جعل من الضمير بيتاً للمقدس، ولكنه جعل من الدعارة موطناً للمدنس الذي ينتصب في مواجهة خصمه أو نقيضه النظيف. ولن يفوتني أن اشير على أن الزواج الوحيد المذكور في المسرحية، هو ذلك الزواج المحرم بين الملك والملكة، والذي يراه هاملت بوصفه دعارة صريحة لأن الدين المسيحي يحرمها بكل تأكيد، إذ لايجوز لرجل أن يتزوج أرملة أخيه كما أن الحب النبيل، حب هاملت لأوفيليا، فمكتوم وآيل إلى الدمار.
ويلوح لي أن ماأراده شكسبير يتلخص في أن انتهاك المقدس هو أحط أشكال الفساد وهو ما يمارسه الملك والملكة، أي ذروة السلطة. وفي الحق أن شكسبير عدو لكل سلطة. فلئن كان ماركس قد صرح بأن « كل سلطة قمع »، فإن الكثير من مسرحيات شكسبير يضمر فكرة فحواها أن كل سلطة فساد. وأظن أن الكاتب قد أراد أن يقول مافحواه، فضلاً عن إدانة السلطة، أن جميع الصلات القائمة في المسرحية هي صلات فاسدة وغير إنسانية، بل صلات جوهرها النفاق بكل وضوح، اللهم باستثناء الصلة التي تربط هاملت بصديقه هوراشو المترع بالروح والطيبة ومكارم الأخلاق.
وههنا قد يجوز الزعم بأن شكسبير في مآسيه الكبرى لايؤمن بأن الإنسان مخلوق على صورة الله. فمه أن بعض البشر طيبون، كما يظهرون في تراثه كله، وهذا تجسيد لفكرة بروتستانتية خلاصتها أن الله قد خصَّ بعض الناس بنعمته الروحية، مع ذلك فإنه يعطي انطباعاً خلاصته أن الإنسان ( ولا سيما باغو في مسرحية « عطيل » والملك في مسرحية « هاملت » ) قد صيغ على صورة الشيطان بالضبط. يقول هاملت : « نعم، ياسيدين أن تكون شريفاً هو في حقيقة الأمر أن تكون قد اصطفيت من بين عشرة آلاف. » (189،188،2،2).
ومع أن هاملت يحب أوفيليا حباً حاراً ونقياً بالفعل، وذلك كما اتضح في برهة دفن الفتاة التي أغرقها النهر، مع ذلك فليس في المسرحية من حضور للحب لأن هاملت قد بلغ به تضاده مع شرطه الاجتماعي الفاسد إلى العدمية، فنصح أوفيليا بالذهاب إلى الدير والبقاء في حال العزوبية الدائمة بدلاً من الزواج وإنجاب الحياة. وتنطوي هذه الفكرة على فكرة أخرى مؤداها أن الحب والزواج والإنجاب هي شؤون متعذرة في هذا الشرط الفاسد الملوث الممروض، وأن العدم هو مايليق بهذه الحياة التي تحكمها علاقات ليست إنسانية بتاتاً. وهذ أشطح بودّي وماهو بالمسيحي.
إذن، يجوز الزعم بأن الاغتيال الذي مارسه كلودينس الملك على أخيه المغدور لم يؤدّ إلى اغتيال شخص واحد فقط، بل أدى إلى اغتيال الحياة كلها في القوت نفسه. وبسبب الموت الشامل الذي يغلغل في مملكة الدنرك بأسرها ( أي في الحياة بمجملها )، كما يرى هاملت، فقد اضطر إلى خنق الحب العارم الذي يكنه لأوفيليا، وأن ينصحها باللجوء إلى الدير حيث لاولادة ولاإنجاب ولا أي جهد تبذله الحياة من أجل تجديد نفسها.
والحقيقة أن شكسبير يتهم السلطة ويحملها مسؤولية كل ما يجري في الحياة من فساد. ففي حوار يدور بين هاملت وروز نكرانتس يقول الأول بأن الدنمرك سجن، فيضيف الثاني بأن الدنيا نفسها سجن. وعندئذ يقول هاملت : « سجن حقيقي، مملوء بالقيود والسراديب والزنازين. إن الدنمرك واحد من أسوأ السجون. » (139،138،2،2).
***********************************
ولدى التأمل المتأني قد يتيسّر للمرء أن يرى هذه المسرحية وهي تتألف من ثلاثة عناصر على الأقل، وهي القتل، وضمنه الانتحار، والزنا واحتجاج الضمير النقي. ومما هو معلوم أن الإحتجاج تقليد بروتستانتي ارساه لوثر وسواه من كبار المحتجين في عصر النهضة. ويلوح لي أن هاملت يحمل بعضاً من صفات لوثر،ولاسيما تربيته وقلقه أوترتره الشديد، وحرارته واشمئزازه ورفضه لكل زيف أو فساد، ثم إدانته لما هو قائم أو سائل. وربما جاز الزعم بأن عدمية هاملت نفسها قد تجدلها جذراً في شخصية لوثر قبل سواه. ولاأدري ماإذا كان النقد في الغرب قد تنبه لأوجه الشبه القائمة بين لوثر وبين هاملت الذي يختبىء شكسبير وراءه دون خفاء.
أما الفرق بين الاثنين فيتلخص في أن الأول يحتج على الفساد الذي يلتهم بنية الكنسية، على حد قوله، بينما يحتج هاملت على الفساد الذي يلتهم بنية الدولة، بل يلتهم الدنيا بأسرها. لقد رأى شكسبير أن المضلة الكبرى تكمن في البنية السياسية وليست في البنية الدينية. وعندي أن هاملت لم يكن في مقدوره أن يجيء إلى الوجود قبل لوثر الذي أسراه شرطه الشارط حقاً. وهذا يعني أن مسرحية « هاملت » ليست مسيحية اللباب وحسب، بل هي إنجاز بروتستانتي على وجه الحصر والضبط، سواء أكان شكسبير البروتسانتي المذهب يدرك ذلك أم لايدركه.
ولكن لابدلي من التصريح بأنني أتنصل من الاعتقاد بأن يكون لب الأمر، أوسر المزية، في هذه المسرحية الخالدة النادرة، فكرةً مؤداها أن ذلك الشاب الذي يكابد الشقاء والاحباط ومرارة العيش، ويرى الدنيا عجوزاًإبالية ورهاء، ولاخير فيها بتاتاً، هو شخصية احتجاجية تشبه شخصية لوثر، وذلك لأن صميمها يتلخص في الرؤيا المأسوية التي تعرضها المسرحية، ولاسيما في جنون أوفيليا وموتها المفاجىء والحامل لمحمول جوهري هو الشعور الكارثي أو المأسوي نفسه. ففي الحق أن الكاتب يرى المأساة وهي تغمر الدنيا بأسرها وتنسج نسيج الحياة البشرية في كل مكان وزمان، حتى لكأنه لايرى شيئاً في الوجود سوى الفاجع أو الكارث. ولهذا فقد راح هاملت ينصح أوفيليا بدخول الدير والكف عن ممارسة هذا العبث العابث، بل هذا العبث الشديد القذارة والفساد. ومما يجب أن لا يفلت من شبكة الانتباه أنه نصحها بالدير ست مرات في ذلك اللقاء الذي جمعهما لأول مرة.
وههنا يلتقي هاملت، او شكسبير الحساس، مع روح المسيحية التي لاترى إلا عالماً ساقطاً إلى الأبد، ولا أمل البتة في تخليصه من سقوطه الذي هو انحطاطه أو الفجيعة التي لايتيسر اجتنابها، وأن كل فرد متميز في هذا العالم (هاملت الذبيح، وأوفيليا الغارقة (المنتحرة؟) الماء، وهوراشو الذي شرب السم عمداً فمات ) هو كائن منذور للصلب، شأنه في ذلك شأن السيد المسيح نفسه. وههنا يتبدى الشبه بين هاملت وبين أصله الرخم في شخصية الاله المصلوب ( وفقاً للعقيدة الوثنية، والمسيحية فيما بعد ). إن لحاء هاملت هو الذي يشبه لوثر، أما نواته أوصميمه فيشبه الأضحية بالدرجة الأولى، أي إنه يكاد أن يكون كبش فداء يفتدي عالماً ساقطاً إلى الأبد، شأنه في ذلك شأن السيد المسيح، وفقاً للديانة النصرانية نفسها.
هذا هو السطر الأول في في مسرحية « هاملت » : « من أنت؟ » ومما لايخفى البتة أنه سؤال الهوية، أو سؤال الماهية الداخلية بالضبط. إن عليك أن تحدد ماهيتك، أن تجيب عن هذا السؤال الزردشتي : هل أنت مع الخير أم مع الشر ؟ إذن، هذا هو السؤوال الجوهري في مسرحية « هاملت » كلها. وربما جاز الزعم بأن المسرحية باسرها جواب عن هذا السؤوال الذي يشكل سطرها الأول حصراً إن شكسبير مهموم جداً بهذه المثنوية الزردشتية.
يقول هوراشو : « ولكن انظروا إلى الصباح المتدثر بدثار وردي، ويسير على ندى تلك الربوة الشرقية العالية. ».
(الفصل الأول، المشهد اول، 166-167) ولعل في الميسور الزعم مرة ثانية أن شكسبير يريد أن يصنع ضداً للسواد الذي يسفع الحياة في المسرحية، ولاسيما بنية الدولة الدنمركية حينئد. وكأنه يريد أن يقول : إن الأزهرارو الصحية من نصيب الطبيعة، أما البلاط فما حل وعقيم ومريصن ولا مصير له سوى الكارثة.
ويلوح لي أن الذهن البشري، حين يلتزم بمثنوية الخير والشر، فلا بدله من التفكير بمثنويات أخرى موازية، مثل الصحة والمرض، ومثل الانجاب والعقم. فمما هون لافت لانتباه اللبيب ههنا أن هذه المسرحية لاتضم في مجالها أيما طفل بتاتاً، بل هي لاتضم ية زوجة سوى الملكة التي ترتبط برجلها الثاني، ولا أقول زوجها، برباط آثم، فضلاً عن أنه عقيم. إنه عالم بلاغد هذا العالم الذي يراه شكسبير البالغ إلى تخوم العدمية البودية.
أما أول كلمة يقولها هاملت في المسرحية فهي هذه : « أنا أكثر من قريب بقليل، ولكنني أقل انتماءً إلى صنفك.» وهو بهذا القول يخاطب عمه الملك، فيصرح له بأنه من أقربائه في الدم، وليس في الروح. وفي هذا تأكيد على الفرق أو على هوية الفرد وخصوصيته التي رسختها البروتستانتيه التي هي ديانة البرجوازية الصاعدة في أوروبا يومئذ. وهو يقول هذه الجملة المفتاحية في البيت الخامس والستين من المشهد الأول في الفصل الأول. وهذا يعني أن القرابة بين هاملت وعمه تأتي من جهة الجسد الذي تحتقره المسيحية أيما احتقار.
وحين يسأله الملك قائلاً : « لماذا لازالت الغيوم تخيم فوقك ؟ » (66،2،1)، فإنه يجيب قائلاً : « ليس الأمر كذلك، ياسيدي، فانا في الشمس إلى حد بعيد.» (67،2،1) ومن الواضح تماماً أن الملك قد جاء بكلمة « الغيوم » لتكون بمثابة كناية عن الغم الذي يهيمن على هاملت منذ موت والده قبل ذلك الوقت بشهر أو أكثر بقليل.
اما هاملت فقد جاء بكلمة « الشمس » والدة النور المضاد للغيوم ذات الطابع الظلامي، وذلك ليتخذها كناية عن الوعي حصراً. هذا بالإضافة على أن النور مقولة كبرى من مقولات الديانة المسيحية. فهي تؤشر إلى الاستنارة وافيمان، بل حتى إلى شخصية السيد المسيح الذي هو النور وأمير النور في آن واحد. ثم يشير هاملت إلى أنه يعي مايجري، أي نه في النور، مرة ثانية، وذلك حين يقول : « ولكن ثمة في داخلي ماينّد عن البصر ». (85،2،1) ومع أن هذه العبارة قد تتضمن ما فحواه أن باطن الإنسان لايرى بالعين الخارجية بل بالعين الباطنية وحدها، إلا أن هاملت يريد التأكيد مرة ثانية على الوعي الشبيه بالنور والمستنب في سريرة الإنسان. وههنا يلوح لي أن هذه المسرحية هي مزيج من وعي الدلالة ووعي الثمالة، أي من الذهن والوجدان، في آن معاً.
وبعد ذلك بقليل يشرح هاملت حقيقته النفسية في أول مناجاة له. وههنا تراه يشير إشارة سريعة، ولكنها صريحة إلى الرغبة في الانتحار. وفضلاً عن ذلك، فإنه يقول : « لكم تبدو لي منهكة، بالية، كئيبة وغير مجدية جميع أمور هذا العالم بأسره. » (134،133،2،1) وههنا تتبدى بكل نصوع شفاف عدمية هاملت الذي ابصر نواة الوجود نفسها. وبذلك فق هيأه الكاتب للموقف العدمي الذي سوف يقفه في حواره مع أوفيليا، وذلك في المشهد الأول من مشهد الفصل الثالث.
ولكن الضمير النقي يتبدى للعيان حين يصرح شبح الملك المغدور بأنه سوف يظل يتعذب في نار المطهر ريثما تحترق الذنوب التي ارتكبها في الدنيا. فمما يقض مضجع الشبح أنه مات قبل أن يعترف بخطاياه، وذلك لأن الاعتراف يخلصه من العقاب بعد الموت. ومن شأن هذا كله أن يتضمن مافحواه أن الرجل نادم على كل خطيئة عاشها خلال حياته. والندم دليل واضح على نقاء الضمير. ومما هو بيّن في ذاته أثناء هذه اللحظة نفسها أن الشبح يقول لهاملت : « إصغ، إصغ، إصغ. » (32،5،1).
إن على الإنسان الطيب أن يصيخ السمع للواقع، أي أن يدرك مايجري بدقة. ثم يضيف الشبح قائلاً : « ياللهول ! ياللهول ! ياللهول ! » (80،5،1) وليس بخاف أن هذين المقبوسين ينطويان على توجيه المرء باتجاه الوعي أو الإدراك. وفي هذا تأكيد على أن الذهني في هذه المسرحية لايقل حضوراً عن العاطفي أو الانفعالي.
ثم إن الشبح نفسه ينم على سمو أخلاقي ينطوي في داخله على نقاء اصيل، لأنه يصدر عن ضمير حي ونقي، وذلك حين يوصي هاملت بأن يترك أمه نفسها لضميرها. فهاهو ذا يقول : « اتركها. للأشواك التي تقيم في صدرها. » (87،5،1) أي اتركها لضميرها الذي سوف يعذبها لامحالة لأنها ارتكبت الشرحين تزوجت شقيق زوجها الأول. وبهذا التعذيب الداخلي الذي تمارسه على نفسها، فإنها تنال القصاص الذي تستحق.
وبعد أن يصف هاملت نفسه بأنه جد كئيب، وذلك في قطعة نثرية نادرة في قوتها، فإنه يصرّح بان الأرض ليست سوى جرف صخري ماحل وعقيم (288،2،2) ثم يضيف على الفور بأن هذا الكون الرائع جداً، هذا السقف الملكي، لايتبدى له إلا بوصفه « غلطة ووباء وجشداً من الأبخرة » ثم يتلو ذلك قوله بأن الإنسانن هذا الانجاز الرائع الشبيه بالملاكن لايزيد عن كونه شيئاً من فصيلة الغبار. وههنا تراه يضيف على الفور : « إن الرجل لايبهجني ، لا، ولا المرأة أيضاً. » (299،298،2،2).
وينتهي هذا المشهد الثاني من الفصل الثاني، وهو الذي أراه أغنى قصول هذه المسرحية، بقول هاملت بانه يريد أن يكتشف ضمير الملك بواسطة مسرحية سوف يمثلها ممثلون وافدون عنوانها « مصيدة الفئران »، وهي التي لاتمس الأرواح البريئة بتاتاً، على حذر عمه. ولكن الملك يصرح قبل أن يشاهد المسرحية الاختبارية بأن ضميره يعذبه كأنه سوط موجع، وذلك لأنه يستخدم النفاق في علاقته بالآخرين (50،1،3).
وفي مناجاة للملك يعترف صراحة بجريمته النتنة التي بلغت رائحتها إلى عنان السماء. (36،3،3) ثم يطلب من السماء الطيبة مطراً يكفي لغسل يديه الآثمتين حتى تصيرا نظيفتين أو بيضاوين كالثلج.(46،45،3،3) ومما هو واضح أن شكسبير قد جعل هذا القاتل الجلف يشعر بتوبيخ الضمير. حتى هذا المجرم العاتي الذي قتل اخاه غدراً يعذبه ضميره في عالم شكسبير القائم على أرضية مسيحية. بل هو يستنجد بملائكة السماء كي تخلصه من العذاب الوجداني الذي يسوطه دون رحمة. وبذلك يملك المرء أن يعتقد بأن الضمير هو بطل مسرحية « هاملت أمير الدنمرك » بالفعل.
ومن شأن لحظة الاستنجاد بمطر سماوي يقدر على أن يجعل يديه نقيتين كالثلج أن يذكّر المرء بليدي ماكبث التي تقول، بعد الجريمة التي شاركت زوجها بارتكابها، إن عطور العرب كلها لاتنظف يدها الملطخة بدم برىء. (41،40،1،5) أما مسرحية « صيد الفئران »، وهي مسرح داخل المسرح، فهدفها أن يتأكد هاملت من أن عمه قد اغتال اباه، أي أن يبلغ إلى الحقيقة من خلال سبر الضمير عبر اسفزازه. وبالفعل يصاب الملك بنوبة مرض مفاجىء حين راح يشاهد جريمته وهي تمثل على خشبة المسرح. إن هاملت لايريد أن يقتل عمه لأن شبحاً قد يكون وهمياً أوحى إليه بأنه ضحية غدر خسيس. إذن، لابد من إثبات صحة الجريمة كي لايكون الملك الذي سوف يقتل قد تعرض للحيف.
وههنا يملك المرء أن يؤكد ما فحواه أن هاملت لم يفتر ولم يتردد في الثأر لأبيه. لقد أصاب نيتشه حين قال في كتاب له عنوانه « ولادة المأساة من روح الموسيقى » بأن هاملت قد « نظر في قلب الأشياء ». ولكن نيتشه لم يحالفه السداد حين اضاف مافحواه أن هاملت قد كف عن العمل بسبب هذه الرؤية العميقة أو الثاقبة. ففي الحق أن ذلك الشاب لم يكف عن العمل من أجل قضية أبيه المغدور، والدليل على ذلك أنه قتل بولونيس ظناً منه أنه عمه، وتسبب في قتل الرجلين المكلفين بمراقبته لصالح الملك، أعني زوزنكرانتس وغلدنستيرن. كما أنه قتل لرتيس في مبارزة عادلة لأنه متواطىء مع السلطة ضده. ثم قتل الملك نفسه عقاباً له على اغتيال والده. أو كل هذا ويقال بأنه كفَّ عن العمل؟.
لقد رفض هاملت أن يقتل الملك وهو يصلي لأته عندئذ سوف يذهب إلى الجنة. وهذه مكافاة وليست عقوبة. فالملك قتل والده فجأة، أو قبل أن يجد الوقت الكافي للتكفير عن ذنوبه، قتله وهو يتمرغ في الآثام، أو وفقاً لما صرح به : « مع جميع جرائمه الواسعة، والمتوهجة مثل شهر نوار. » (81،4،3) وههنا قد يخطر في بال المرء أن مايبتغي شكسبير ان يؤكده هو هذا : ما من شيء في الريعان سوى الجريمة، أو سوى الشرو وحده.
وتفاقمت الحداث الان وافتحلت، بعد ما اقدم هاملت على قتل بولونيس، والد أوفيليا ولرتيس، ظناً منه أنه الملك وقد اختبأ وراء الستار ليسمع الحوار الدائر بين هاملت وأمه، التي قال بانه سوف يكلمها خناجر. وفي ذا الحوار نرى هاملت وهو ينصح تلك المرأة بان تعترف بذنبها أمام الله، وبأن تندم على ماارتكبته من ذنوب، وألا ترش السماد على الأعشاب الضارة لتصير أكثر فساداً. (149،147،4،3) وفي هذه الدعوة إلى الاعتراف بذنبها، ثم الندم على ماسلف من إثم، فغن هاملت، الذي يصدر ههنا عن التقليد المسيحي، يحرض ضميرها على أن يصحو لتدرك ماهي فيه من فساد بسبب زوجهاغير الشرعي من شقيق زوجها. ولقد سلف أن صارحها بان ماتفعله هو الزنا بالضبط. وقبل أن يغادرها وهو يجر جثة بولونيس قال لها بانه سوف يطلب بركتها عندما ترغب في أن تكون مباركة من الرب، أي طاهرة بغير آثام. (167،166،4،3) وفي هذا كله تأكيد قوي على أم مسرحية « هاملت » تصدر عن الديانة المسيحية، أو عن مذهبها البروتستنتي حصراً.
********************************
ويبلغ الفاجع أوجه بجنون أوفيليا وموتها غرقاً في الماء واهب الحياة والري. إن هذا الحزن اليسوعي الجليل قلما يملك أن ينتجه أحد سوى شكسبير الجليل. لقد غرقت في النهر تلك الفتاة التي كانت مرشحة للزواج من هاملت بغية إنجاب الحياة. وههنا تكمن مفارقة مهيبة : إن الماء، صانع الحياة، قد أفنى الفتاة القادرة على تجديد الحياة. وههنا تتبدى هذه المسرحية وكأنها إجاض لما هو مضمر أو مكنون في جوف الممكنات. فقد انتحرت اوفيليا، أو ماتت غرقاً، وذلك نتيجة لما أصابها من جنون. وبموتها قد يشعر المرء أن المستقبل تعرض للإغلاق. فما من امرأة أخرى في المسرحية كلها مهيأة للإنجاب سوى اوفيليا. ويبدو أن الكاتب قد تعمد أن يكون موتها بالماء. وربما كان اللاشعور هو الذي تعمد ذلك. فكأنه يريد أن يقول بان الحياة (ممثلة بالماء ههنا) تقتل الحياة وتبيدها أو تخرجها من الوجود. وفي هذا المنحى تكمن فكرة صراع الإنسان ضد الإنسان.
ومما هو مفيد ههنا أن أذكر ما فحواه أن أخاها لرتيس ينعتها بأنها « زهرة نوار ». ويبدو أن الكاتب قد أراد أن يقول بأن انطفاء هذه الزهرة ليس انطفاء الربيع وحده، بل انطفاء الحياة كلها. ومما هو لافت للانتباه أن عدداً كبيراً من الزهور، ولاسيما البنفسج، يذكر في هذه المسرحية التي تسير بالتدريج نحو الذبول أو نحو زوال. إذن، عقم وزهور في آن واحد.
وعندي أن اوفيليا هي الكارث، بل هي الألم والحزن والأسى، أو قل إنها الشيء في ذاته الذي لم يستطيع أمانول كانت أن يعثر عليه في داخل الأشياء. ولا أحسب أن سيد جميع الكتاب الأدبيين في التاريخ البشري باسره قد أنجز شخصية نسوية أكثر تأثيراً في النفس من اوفيليا، لاكورديليا ولاميراندا ولا بورشا. وقد استثنى شخصية دزدمونه وحدها. ولا ضمير إذا ما نوهت ههنا بأن شكسبير شديد القدرة على تصوير شخصيات نسائية ذات أرواح فاتنة. ولسوف أغامر وأصرح بأنه قد تعلم هذه المزية من دانتي، ذلك العاشق الملهم والنادر في تاريخ الجنس البشري كله.
فبينما كانت ملكة الدنمرك تتوقع أن تصير اوفيليا زوجة لابنها هاملت، وأن تزين الزهور فراش عرسها، لا أن تنثر على قبرها، (232،230،1،5)، فقد فوجىء الجميع بموتها الفاجع بعد ماجنّت بسبب وفاة والدها. وحين رأى لرتيس العائد من انجلترا جثة أخته وهي توشك أن تنزل إلى القبر، فإنه يرمي بنفسه داخل الضريح، ثم طلب من الناس أن يهيلوا التراب عليه وعلى جثة أخته معاً. ولكن هاملت العائد من البحر، بعدما كان في طريقه إلى انجلترا، قد شاهد الدفن الوشيك، فوثب إلى القبر هو الآخر واشتبك بالأيدي مع لرتيس الذي رأى فيه سبباً لموت اوفيليا بعد ما قتل أباها. ولكن هاملت يقول الآن في هذه البرهة الكاشفة للمكنون : « لقد أحببت اوفيليا إلى الحد الذي يعجز عنه أربعون ألف أخ، يحبونها حباً كبيراً جداً، فيبقى حبهم لايعادل حبي.» (157،155،1،5).
أما بقية أحداث المسرحية فهي نتيجة طبيعة، بل حتمية لماسبقها من أحداث. وقد أكون على صواب إذا ما صرّحت بأن المقتلة التي تنتهي بها المسرحية لاتثير الشجن كثيراً، وذلك لأنها فقدت عنصر المفاجأة وصارت بحكم الأمر الحتمي، أو ذالك الذي يسمونه تحصيل حاصل. ولهذا أملك حق الزعم بأن عنصر الشجن الأصيل في هذه المسرحية يتجلى عندما تدلف اوفيليا إلى طور جنونها، ثم عندما تموت. وهذان أمران لم يكونا متوقعين بتاتاً.
وههنا، ارى أن من المناسب أن أذكر رأياً طريفاً لواحد من أشهر نقاد شكسبير، وهو ا.س.برادلي، عرضه في كتاب له عنوانه « مآسي شكسبير »، الذي نشر سنة 1904،فصار مشهوراً جداً طوال القرن العشرين كله تقريباً. يقول برادلي بأن بطل المأساة عند شكسبير يذهب إلى حتفه كما لو أنه ذاهب إلى حفلة عرسه. ومع أن هذه الفكرة هي موضع ريب عندي، فإنها لاتنطبق على أحد من أبطاله الماسويين أكثر مما تنطبق على هاملت حصراً . فقد رأى هاملت من الشر والتعفن والفساد والنفاق والعدوان ماجعله يشعر بالغثيان ويفضل العدم المحض على هذا الوجود الذي لايملك إلا ان يكون خمجاً مذراً لايرجى له أي صلاح. ولكم أصاب ناقد آخر من بلدان الغربيين حين لاحظ بأن هاملت ميت منذ بداية أمره. وبما أنه ميت سلفاً، فإن موته لايفاجىء ولايدهش بتاتاً.
*******************************
لااحسبني قد وفّيت هذه المسرحية حقها من الشرح والتفسير، بل أخالني تركت الكثير مما يحتاج إلى سبر وربما إلى تأويل ولكنني قد فعلت شيئاً مافي هذا الموضع، كما أن مافعلته هو احسن من لاشيء. وعندي أن من واجبنا نحن العرب أن نقوم بدراسات نكرسها لتقيم المنجزات الأدبية العالمية، ولاسيما الأوروبية، منذ الإليادة والأودنيسة حتى أوائل القرن الراهن. فلا ريب في أننا مقصرون في هذا المضمار الذي يحتمه علينا مبدأ المعملة بالمثل. ولهذا، فغن من واجبنا أن نتدارك هذا التقصير، وذلك ابتغاء اللحاق بالركب العالمي الحي، أو ابتغاء المشاركة في الحياة الكونية، بعدما دخلنا حقبة الركود الميت.
وعليّ أن أعترف بأن سماتها الجمالية لم تنل حقها من العرض والتبيان، مع أن يخضورها المخضب بالحيوية والعافية قد جعل منها تحفة فنّية نادرة في تاريخ الكتابة الأدبية واتضحت أصالتها في وضاءة الأسلوب الحي، من جهة، والكثيف من الجهة الأخرى. وكان من شأن هاتين السمتين، أعني الكثافة والحيوية أن مكّنتا الأسلوب من جمع المتانة واللدانة في بنية تركيبية واحدة. وفي الحق أن الأسلوب في هذه المسرحية الخالدة قد بلغ كمال اقتداره على التعبير الخاطف الشفاف، وذلك بفضل كونه مزيجاً من التكثيف والتلطيف والجرأة على الاقتحام. وعندي أن السلوب هو كل شيء في الأدب، وأن كل كاتب أدبي هو أسلوب خاص يتفرد به صاحبه ويتميز ويعزف من خلاله، وذلك لأنه يتماهى معه إلى حد التطابق.
وأخيراً، أشعر بأن بي رغبة في التأكيد على واجبنا، نحن العرب، تجاه أنفسنا، أو تجاه وضعنا الدوني في العالم الراهن الذي يتميز بحراك تاريخي لم يعرفه أي زمن سالف. عن علينا أن نعود من جديد إلى سياق التاريخ أولى مجراه الحي، وأن ننتزع الزمان من أشداق الفراغ، وأن نساهم في تطوير الثقافة البشرية كما كنا نفعل منذ غابر الدهور وحتى عهد قريب. لقد أفضينا مئات السنين نتمطى على أرصفة التاريخ، أو على هوامشه الشديدة الضيق، حيث رحنا نترهل ونتخمج، ثم نكتفي بالصراخ نتخذه بديلاً، أوتعويضاً زهيداً عن الفعل الحي. وهذا يعني أننا قد دخلنا في طور انعدام الوزن، اوخرجنا من الوجود الأصلي إلى الوجود الزائق البليد