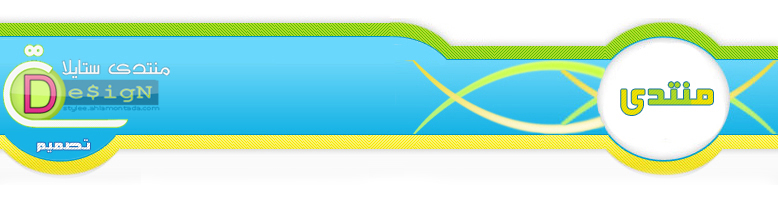والمؤسف أن الواقع الذي تعرفه مؤسساتنا لا يمت بصلة إلى هذه الغايات النبيلة للعمل المدرسي، فأقل ما يمكن أن يقال عن هذه المؤسسات أنها بيئات تقتل الإبداع وتقمع الفكر والذكاء، ولا تمثل بالنسبة للطفل مجالًا للارتياح والتفتح والانفتاح بقدر ما تبدو كمكان للخوف والقلق والضجر، وهو وضع يعرقل النمو السليم لشخصية الطفل، بل يشوه تنشئته الاجتماعية.
ولعل أسباب هذا الوضع ناتجة عن عوامل منها تردي الفضاء المدرسي، وضغوط المهنة التعليمية، وشيوع تمثلات سلبية عن الطفولة.
وأحد عوامل كره المدرسة هو طبيعة فضاء المؤسسة التعليمية وأجوائها؛ فمؤسساتنا تتصف بضيق مساحاتها وقلة مرافقها وتجهيزتها وكثافة عدد التلاميذ في الحجرة الدراسية الواحدة، وشكل المقاعد وتصميمها السيئ وحالها المتردي؛ والنظام المدرسي صارم وحازم لا يراعي ظروف نمو الأطفال ولا طبيعتهم اللاهية، والمنهاج الدراسي مثقل وجاف لا يراعي حاجات الطفل إلى التعلم الذاتي النشيط ولا رغبته في اكتشاف العالم واحتوائه وممارسة حواسه وقدراته ومهاراته بشكل مباشر في تناول المعرفة؛ فضلًا عن العلاقات السائدة في مؤسساتنا المدرسية بين المدرسين والتلاميذ والتي لا تستجيب لأدنى رغبة للطفل أو أبسط حاجة من حاجاته. فالجو المدرسي العام يفتقد كل الشروط الجمالية والمقومات الأساسية التي تجعل منه فضاء مقبولًا من التلاميذ، بما يمكن أن يتيحه من شروط الراحة النفسية التي تشجع الأطفال على الاطمئنان والركون إليها، حتى أن المدارس أضحت كمعتقل يلزم الطفل بقضاء فترة عقوبة داخله لأجل ذنب لم يرتكبه.
إن الحق في التعلم المنصوص عليه في المواثيق الدولية واضح يلزم الموقعين عليها بتوفيره للأطفال بدون ميز، وهذه المواثيق تحدد في فصول متعددة نوع هذا التعليم الذي ينبغي أن يتم في ظروف آمنة يحظى فيها الطفل بكل الاحترام، وبشروط تحقق لمهاراته ولقدراته النمو والتطور وتضمن له فرص ممارسة حقه في التعبير الحر عن آرائه، والحصول على المعلومات وتكوين الجمعيات وغير ذلك من الفصول التي تتيح للطفل فرصًا قمينة بالاعتبار لتنمية قدراته إلى أقصى حد ممكن.
إلا أن التعليم المدرسي عندنا لا يتأسس على مبدأ مراعاة حرية الأطفال وكرامتهم، ومجهود المدارس ينصب أساسًا على ضبط التلاميذ والتحكم فيهم وتلقينهم المعارف المحددة سلفًا دون أدنى اهتمام بحاجاتهم إلى النشاط والحيوية وإثبات الذات وإلى العلاقات التبادلية المطبوعة بالمودة والمتأسسة على الثقة في النفس. ولعل أسباب هذا القصور تعود إلى قلة الإمكانات المادية المتاحة لهذه المؤسسة والطبيعة الجافة والمحافظة للتعليمات والقوانين التي تتحكم في عمل المؤسسات وتضيق الخناق على المبادرة الحرة، إنها بعبارة موجزة مدرسة غير مريحة، بل مثيرة للنفور.
ضغوط المهنة
إن التعليم لا يقتصر على تلبية الاحتياجات المعرفية للطفل بل يتجاوزها إلى تلبية مطالب نموه البدني والاجتماعي والنفسي والعقلي، وهذا التعليم المدرسي الذي نحن بصدد الحديث عنه يتخذ من المدرسين الأداة الدافعة لعجلة تطوره والمحركة لقلبه النابض، فالمدرسون قلب هذا الجهاز النابض بالحركة وذراعه التي يتأتى له بها تحقيق أغراضه، والمدرس عامل كبير الأهمية في المؤسسة المدرسية لأنه يكون مع التلاميذ لفترة طويلة ويتفاعل معهم باستمرار، يخدمهم لتلبية الاحتياجات السالف ذكرها، ويؤثر في شخصياتهم ويقوم بدور هام في توجيههم؛ وطبيعة عمله تحتم عليه أن يخدم التلاميذ يساعدهم في تعلمهم ويحقق تكيفهم الذاتي والجماعي الذي بدونه لا يمكنهم النجاح في حياتهم الدراسية. إلا أن وضعه جزء من وضع المؤسسة التي ينتسب لها، ودوره لا ينفصل عن دور المدرسة التي يعمل بها، فالعوز والفقر المالي وتردي البيئة المحيطة وغياب التجهيزات والوسائل المادية، وهاجس النظام والانضباط، كلها أسباب تجعل المدرسين مستغرقين في البحث عن أساليب ووسائل مجابهة ظروف وإكراهات الحياة المعيشة قبل التفكير في تطوير الممارسة المهنية والإبداع في الحقل التربوي، ويكون الهاجس المهيمن هو التحكم في هذه الطفولة المشاغبة والحد من مشاكساتها وجرأتها التي لا ترحم.
ويرتب المدرسون في صدارة المهن التي يعاني المنتسبون لها الصعوبات الصحية والانهيارات العصبية والنفسية والبدنية نتيجة ضغوط العمل المتعددة، هذه الضغوط تشكل عاملًا مهمًا من عوامل تردي النظام التربوي، فثلاثون ساعة أو ما يقاربها من التدريس في فصول مكتظة عمل شاق جدًا، يضاف إليها ساعات العمل الأخرى التي يتطلبها العمل المدرسي من تحضير وإعداد للدروس وتصحيح أعمال التلاميذ، فضلًا عن أن ذلك كله يتم في ظروف سيئة مادية وأدبية واجتماعية. وانشغالات المعلمين وظروفهم الاجتماعية والمالية ومشاكلهم، كلها أسباب تتضافر لتحول دون بذل المدرسين الجهد في سبيل التقرب من الأطفال ومنحهم ما يحتاجونه من عناية واهتمام، فتفقد العلاقة بينهم الحرارة والتجاوب والتواصل العاطفي، فحين تقتصر وظيفة المدرس على إلقاء الدروس المقررة بين جدران الفصل الدراسي، وفي غياب الوسائل المشوقة وغياب الأنشطة المحققة للمتعة والتعلم، قلما يستمتع الأطفال بمودة معلمهم وعطفه. والطفل في حاجة ماسة إلى هذا العطف والمودة والتفهم.
فلأمر ما يحتد المدرسون في مواجهة التلاميذ ويصرخون في وجوههم، ولعل ذلك يساعدهم على التنفيس عما يعانونه من ضغوط داخلية، لذلك تربط تقارير اليونسيف في كل إصداراتها بين تطوير العمل التربوي وبين تحسين ظروف معيشة المدرسين وأجورهم، لوقف الانحدار التعليمي، فالمدرس المحبط لا يمكن أن يفكر أبدًا في إصلاح ممارساته التعليمية ولا يمكن أن يراعي للطفل حقوقًا ولا حاجات، لأنه ببساطة يستغرقه الانشغال بتوتراته وعذاباته.
نقص الوعي بطبيعة الطفولة وحاجاتها
إن بنود مواثيق حقوق الإنسان والطفل تحدد حقوقًا يعتمد الوفاء بها على المعرفة بالطفولة، وتحديد لمعناها، وإحاطة بمراحل نموها وبمطالب هذا النمو وحاجاته وغير ذلك مما يعد ضروريًا لفهم هذه المرحلة المهمة والحاسمة من عمر الناشئة، وهذه المعرفة ضرورية ومطلوبة ولو كانت أساسية وفي حدود دنيا.
فالبند 26 من حقوق الإنسان ينص على أنه (يجب على التربية أن تهدف إلى تفتيح شخصية الإنسان وتعميق احترام حقوقه وحرياته الأساسية) ويتساءل جان بياجيه في مواجهة هذا النص قائلًا هل تتمثل وظيفة التربية في مساعدة الطفل على تفتيح شخصيته أو تتجسد وظيفتها أولًا وأساسًا في تشكيل الأفراد حسب نموذج معين يتطابق مع ما قدمته الأجيال السابقة ويكون كفيلًا بالمحافظة على قيم المجتمع؟ ويضيف معلقًا إن التربية التي تساعد على تفتيح شخصية الطفل تشكل مطلبًا يتعارض مع الأهداف المعتادة للتربية المحافظة.
وحتى لو غضضنا الطرف عن هذا الميثاق، فإن من البديهي أن الطفل في حاجة دائمة إلى رعاية ومساعدة، وقد أقام المجتمع مؤسسات عمومية لتوفير ذلك للطفولة، وهذه المساعدة تتم إما بشكل مباشر بتدخل فعلي عن طريق إنشاء مؤسسات احتضان الطفولة كالمدارس ودور الشباب والأندية والحدائق وغيرها من المرافق، أو بشكل غير مباشر عن طريق ترسيخ حقوق الطفل وبث الوعي في النسيج الاجتماعي بأهمية العناية بهذا الكائن ورعاية نموه وتلبية حاجاته وتحسين ظروف معيشته، وهو ما يروج داخل مؤسسات تكوين العاملين في القطاعات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الشبيبة والرياضة، وغيرها) في شكل دروس ومحاضرات
ْ
________*التــَّـوْقـْـيـعُ*_________
لا أحد يظن أن العظماء تعساء إلا العظماء أنفسهم. إدوارد ينج: شاعر إنجليزي