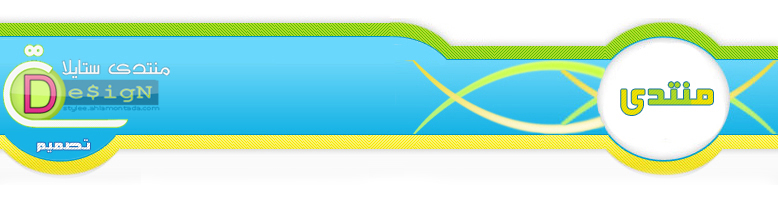لكل عصر تحديات تؤثر فيه سلباً أو إيجاباً، وإنما تختلف التحديات من عصر إلى آخر، باختلاف المراحل التاريخية، وبالتفاوت في الوسائل والإمكانات التي تتوافر لدى الشعوب والأمم للتعامل مع ما يصادفها من صعوبات في الحياة وما يواجهها من عراقيل في طريق تقدّمها وتطوّرها نحو الأفضل والأحسن والأقوم، كما تتباين هذه التحديات من مرحلة تاريخية إلى أخرى حسب طبيعتها، ووفقاً للعناصر التي تتحكم فيها، وللعوامل التي نشأت عنها، وللمناخ العام الذي يهيمن عليها.
والتحديات التي تواجه الأمم والشعوب هي من سنن الله في الكون، فلقد خلق الله الإنسان في كبد، وجعل الحياة عناء لا ينتهي ومكابدة لا تفتر، من أجل إقامة العدل وإقرار الحق وإحلال السلام بين البشر، وعبادة الله وتطبيق تعاليمه في الأرض، وفق الضوابط والأحكام وموازين القسط التي جاءت بها الشرائع السماوية، والتي بلغت كمالها بالشريعة الإسلامية الخاتمة والهادية إلى الخير والحق والفضيلة والداعية إلى السلام في الأرض والمحبة بين بني البشر والتطلع الدائم إلى نيل مرضاة الله بالعمل الصالح في ظل الاخوة الإنسانية التي لا تفرق بين الناس وتجعلهم سواسية كأسنان المشط، فربّهم واحد، وأصلهم واحد.
لقد اكتسح الاحتلال الأوروبي العالم الإسلامي بدءاً من القرن الثامن عشر للميلاد، واكتمل تطويق الاستعمار للأقطار الإسلامية، في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، وفي بداية العقد الثاني من القرن العشرين. ومع أن الدولة العثمانية كانت قائمة في هذه المراحل التي امتدّ فيها أخطبوط الاستعمار والاحتلال إلى البلدان الإسلامية، من سومطرة شرقاً إلى المغرب الأقصى غربا، ومن القوقاز شمالا الى جنوبي الصحراء الكبرى الافريقية جنوبا، إلا أنها كانت قد بدأت في التحلل والانهيار التدريجي بدءا من القرن السابع عشر، وقد سرى في كيانها الوهن طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حتى إذا بزغ فجر القرن العشرين، كانت الدولة العثمانية في حالة من الضعف شديدة، تطورت سريعاً إلى التلاشي والانهيار في نهاية الحرب العالمية الأولى.
لقد كان الاستعمار الأوروبي للعالم الإسلامي تحدياً شديد الضراوة بالغ الشراسة، استهدف الأرض والعقل في آن واحد، وكانت مطامحه بعيدة المدى، ولو لم تقم حركات التحرير الوطنية الجهادية في جميع أقطار العالم الإسلامي بكسر إرادة المستعمرين، وإحباط مؤامراتهم، لكان وضع العالم الإسلامي اليوم بالغ السوء.
بيد أن التحدي الاستعماري للأمة الإسلامية، وإن كان قد انهزم بدرجات مختلفة، في البلدان الإسلامية التي احتلت لآماد متفاوتة، فإنه قد أفلح في اقتطاع فلسطين من كيان العالم الإسلامي، وانتزاعها من السيادة العربية الإسلامية، وعمد إلى إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين المقدسة، في تحد سافر، ليس للعرب والمسلمين فحسب، وإنما للمجتمع الدولي برمته، ولكل ما عرفته البشرية من شرائع سماوية وتشريعات قانونية. ثم تطور الأمر إلى ما نراه اليوم جميعا، من عدوان ظالم على الشعب الفلسطيني، واستباحة كاملة لحقوقه ودماء أبنائه في ظل الدعم غير المحدود لإسرائيل من قبل أكبر قوة في عالم اليوم. لقد ورثت دول العالم الإسلامي، التي بدأت تسترجع استقلالها منذ العقد الثاني من القرن العشرين، أوضاعاً سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية شديدة التدهور مثقلة بالأعباء، فكان عليها أن تخوض معارك متواصلة استهدفت بها إزالة أسباب الانحطاط، والقضاء على عوامل الفقر والتخلف والضعف العام الذي كان يسري في الكيانات القطرية التي أخذت تأسس انطلاقاً من العشرينيات من القرن الماضي.
وكان هذا الوضع تحدياً عنيفاً وتجربة صعبة واختباراً عسيراً، حشدت له تلك الدول إمكاناتها وقدراتها جميعاً للتغلب على المشكلات الناجمة عن هذا الوضع، ودخلت في مواجهات ضارية مع مخلفات عهد الاستعمار لمحو آثاره المدمرة، حى تحقق لبعضها نصيب من التحرر والتغلب على الظروف الصعبة التي واجهتها الدول العربية الإسلامية، ولم يتحقق هذا النصيب لبعضها الآخر، أو تحقق لدول أخرى بقدر أقل، وهي لا تزال تكابد من أجل التخلص من الضغوط المانعة للبناء والصارفة عن النماء.
ويعود جزء من التحديات التي تواجهنا اليوم في العالم الإسلامي، إلى تلك التي سادت في المراحل السابقة، فهي تشكل من حيث العمق والجوهر والهدف والبُعد الاستراتيجي، امتداداً لها. بيد أن جزءاً من تحديات هذا العصر، هو ناتج بالضرورة عن التراكم والتعاقب، وعن عدم البتّ في شأنها بالحسم أو بالمعالجة التي تقتضيها الظروف، نتيجة للعجز والتواكل، أو للجهل بأخطارها، أو للاستخفاف بها جملة، أو لسوء الفهم وانعدام الأهلية للتدبير والتسيير وإدارة الشأن العام. كما أن جزءاً آخر، لعله الأكبر من هذه التحديات، راجع إلى طبيعة هذا العصر، لأنها تمخضت عن التطورات التي عرفها العالم خلال العقود القليلة الماضية في شتى الميادين، خاصة ما يتعلق منها بالعلوم والتكنولوجيا، وبالتربية والتعليم، وبالإدارة والحكم وتدبير الشأن العام، وبالاقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة، وهي الميادين التي تخلفت فيها دول العالم الإسلامي تخلفاً شديداً.
لقد وجد الاستعمار نفسه في بادئ أمره، أمام شعوب مقهورة الإرادة بالظلم الذي يُسلط عليها من أبنائها، منزوعة الثقة بنفسها لطول عهود الاستبداد والتسلط التي تتعارض مع أحكام الشرع الحنيف، فقيرة إن لم تكن معدمة، لجهلها باستغلال الثروات التي حباها الله بها ولهيمنة طائفة منها دون الطوائف الأخرى العريضة، على الأرزاق والخيرات والمكاسب، يهيمن الجهل والأمية على كثير من أبنائها، وهي أمة (اقرأ) التي أخرجها الله من الظلمات إلى النور بالقرآن العظيم الذي ظلت فئات كثيرة في هذه الشعوب تحمله من دون أن تفهمه وتدرك معانيه، وتقرأه من غير أن تفقه مقاصده ومكارمه وأحكامه. وبسبب هذه العلل التي كانت متفشية في جسم العالم الإسلامي، تمكّن الاستعمار القديم من ترسيخ وجوده، وبسببها عجز المسلمون عن مواجهة تحديات الأمس. وإذا تأملنا المشهد العريض في هذه المرحلة، وأمعنا النظر في الأوضاع التي يعيشها العالم الإسلامي، نجد أن كثيرا من هذه العلل، هي التي تنخر في كيانه، وتعوق كل حركة تتجه نحو النهوض الحضاري وتعمل من أجل التحرر السياسي والاقتصادي من ضغوط القوى الاستعمارية الجديدة، مما يتسبب في إضعاف الأمة وإعاقة مسيرتها، والتأثير في قدراتها على التعامل مع التحديات التي تشدها الى الواقع المثقل بالأعباء والمشكلات والأزمات، والتي تدفعها الى المواجهة غير المتكافئة التي تضاعف من التحديات، ولا تحد من آثارها أو تتغلب على العراقيل والمثبطات الناتجة عنها. وهي علل مستشرية على نطاق واسع، متجذرة في النفوس والعقول، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود المتضافرة للتخلص منها.
إن العالم الإسلامي يعيش مرحلة تاريخية محفوفة بالمخاطر الحقيقية، فُرضت عليه فيها تحديات ضخمة، الكثير منها هو وليدُ المتغيرات الدولية المتسارعة التي يهتزّ العالم المعاصر تحت وطأتها، والتي تهدّد استقرار المجتمعات الإنسانية في كل مكان من العالم، وتُلقي بظلالها القاتمة على الحياة العامة فوق هذه الأرض. وفي ضوء ذلك، فإننا نرى أن من أقوى التحديات المعاصرة التي تواجه مسيرة الإصلاح والتجديد والتقدم في العالم الإسلامي، التحديات التي سنعرض لها بالتحليل، في ما يلي:
يوجد العالم الإسلامي في قلب الصراع العالمي المحتدم، مما يجعله مستهدفاً من النواحي كافة، ومعرضاً لمخاطر من جميع الأطراف التي تتصارع في الساحة الدولية. ولقد ترتب على هذا كله، تفاقم التحديات الكبرى التي تواجهها الدول العربية الإسلامية، بصورة تؤثر بشكل عميق، في الحياة العامة، وتنعكس آثارها السلبية على عملية البناء الحضاري بصورة عامة:
ويمكن أن نحصر أهم هذه التحديات في ما يلي:
ـ تحديات سياسية: على مستوى نظم الحكم والإدارة وإقامة العدل وتطبيق الشورى من خلال آليات إجرائية تضمن مشاركة فئات المجتمع المختلفة، واحترام حقوق الإنسان التي اعتبرها الإسلام جزءاً أساساً من مقاصد الشريعة، ودعا إلى صيانتها، ومدى الاستجابة لتطلعات الشعوب العربية الإسلامية، واحترام القيم الثابتة للحضارة العربية الإسلامية، وعلى مستوى الممارسات السياسية داخل تنظيمات المجتمع، ومؤسساته الثقافية والسياسية والاجتماعية.
ـ تحديات اقتصادية: على مستوى الاختيارات الاقتصادية، والإصلاحات، والتطبيقات الهادفة إلى معالجة الضعف الاقتصادي وما يترتب عليه من مشكلات اجتماعية، والتكيّف مع الأنظمة الاقتصادية العالمية.
ـ تحديات ثقافية: على مستوى التنظير، والتخطيط، والعمل الثقافي في حقوله المتعددة لبناء الفكر القويم المنفتح على العالم بروح سمحة وعطاء مبدع، ومعالجة نوازع التطرف والانغلاق، وعلى مستوى المواجهة المتكافئة مع التيارات الثقافية المتعددة الوافدة من الغرب والشرق معاً.
ـ تحديات اجتماعية: على مستوى محاربة الثالوث الخطير، وهو الفقر والجهل والمرض، ومقاومة اليأس الذي يدفع بالشباب إلى الوقوع في شباك التطرف أو الضياع، وعلى مستوى المواءمة بين النظم وأنماط السلوك الحديثة وبين المحافظة على الثوابت والخصوصيات الثقافية والحضارية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي.
ـ تحديات تنموية: على مستوى الجهود المبذولة للقضاء على معوّقات التنمية، وعلى مستوى بناء القواعد الثابتة للنهضة التنموية في جميع الميادين في كل دولة على حدة، وفي إطار التضامن الإسلامي بين دول العالم الإسلامي جميعا.
وعلى الرغم من تعدد وجهات النظر حول الوسائل الأجدى والأنفع لمواجهة هذه التحديات، فإننا نقول بتجديد البناء الحضاري، وندعو إلى مراجعات شاملة للسياسات القائمة في كل الميادين، وبصورة خاصة في ميدان التربية والتعليم. ويشكل التعليم القوي والهادف، القاعدة الأولى للبناء الحضاري، وهو المنطلق الأساس لمواجهة هذه التحديات جميعا، ولكن في هذا المجال ايضا تعاني دول العالم الإسلامي تحديات كبرى، لا بد من مواجهتها والتغلب عليها، وأهم هذه التحديات:
أ) التقدم الهائل في مجالات الاتصال والمعلوميات والتكنولوجيا الرقمية، وقصور الإمكانات المادية والفنية والأكاديمية لدى العديد من دول العالم الإسلامي عن ملاحقة هذا التقدم والتكيف معه.
ب) العولمة وتأثيراتها على تشكيل الهوية وبناء الشخصية، وعدم الإدراك الكامل للمخاطر الحقيقية التي ينطوي عليها نظام العولمة الكاسحة.
ج) ضعف الاهتمام بالبحث العلمي، وقلّة الدعم المخصص للباحثين في مجالات المعرفة المختلفة، سواء من قبل الدولة أو من قبل القطاع الخاص، فالتطور والنمو لا يتمّان إلا بالاستناد إلى توظيف نتائج البحث العلمي توظيفاً سليماً وفعالاً.
د) حرية التعليم التي تنحصر في الدور الذي يُناط بالدولة، دون أن تتاح الفرص للقطاع الخاص وللمؤسسات والمنظمات والجمعيات الأهلية لممارسة الحق في التفكير والاجتهاد لتطوير التربية والتعليم، مما يعطل الطاقات، ويثبط الهمم، ويزرع اليأس من الإصلاح في النفوس، ومما يتعارض كليا مع روح الحضارة العربية الإسلامية والتراث العربي الإسلامي في هذا المجال، حيث كانت تقوم حلقات العلم الحرة في المساجد والجوامع والمنتديات، تناقش فيها بحرية مختلف الأفكار والمذاهب الإسلامية، وتستنبط الحلول للمشكلات والمعضلات التي تواجه المجتمع.
هـ) مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل المتنامية.
ومهما يكن الحال، فإن هذه التحديات ليست مما لا سبيل إلى التغلب عليه، وتجاوزه إلى آفاق أكثر إشراقاً وأوضاع أفضل حالاً، إذا ما تعرّفنا على العلل التي تُضعف كياننا والعوائق التي تحد من حركتنا، وإذا ما بادرنا إلى القيام بعمل جماعي متناسق يعتمد التخطيط السليم والتنفيذ المتقن، وبروح التضامن والتكافل التي هي قبس من حضارتنا العظيمة التي أشرقت على العالم، وسيعود إشراقها، بإذن الله، على الرغم من كثافة السحب وادلهامّ الخطوب، ليتعرف العالم كله على حقيقة رسالتها الإنسانية ونبل مقاصدها، وأنها حضارة تعارف وتعاون، لا حضارة تناكر وتصادم.
ْ
________*التــَّـوْقـْـيـعُ*_________
ليس القويّ من يكسب الحرب دائماً، وإنّما الضعيف من يخسر السّلام دائماً