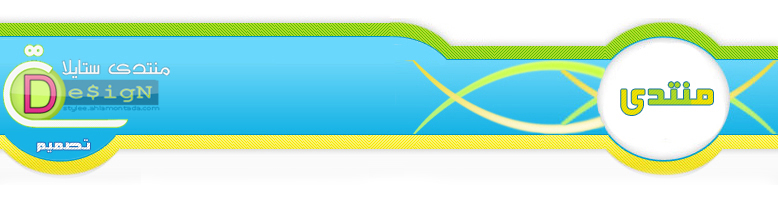سلاف زهرة
حتى يولد الإبداع لا بد أن ينشأ ويكبر في رحم المعاناة ، فالأديب الذي لا يمر في ظروف حياة قاسية لا يمكن أن ينتج أدباً وكتابات متفردة ، ولكن قد يقول قائل « ثمة أدباء ونوابغ في كافة مجالات الحياة تفوقوا وأبدعوا نثراً وشعراً و فناً وقد ولدوا وفي أفواههم ملعقة من ذهب وعاشوا دون أن يعرفوا شيئاً عن الفقر أو التشرد أو الحرمان .
ولكن هنا لا بد أن نعترف أن الأمور نسبية وتخضع لدرجة إبداع كل من هؤلاء بينما الأغلبية ممن قدموا نتاجاً فكرياً خصباً ذو ميزة ثقافية وفنية عالية كان نتيجة وعصارة آلامهم وتجاربهم في حياة لم تقدم لهم أدنى قدر من الرفاهية والترف ، فالبيئة التي نشأ فيها معظمهم لم تساعدهم إلا في تعميق الحزن والتعاسة ليعتصروا منها أدباً خالصاً عميق الدلالة فهو على بساطته وعفويته استطاع بقوة أن يفرض نفسه في ساحة الإبداع الأدبي أو الفني . لم يكتب هؤلاء كي يحصدوا أموالاً وثروة أو ليكسبوا جوائز أو تقديراً من شخصية اعتبارية أو رسمية وإنما كانوا يعبرون عن صرخات بطونهم الخاوية وآلامهم المتزاحمة في ثنايا قلوبهم بسبب واقع تعيس عاشوه في طفولتهم وامتد حتى شبابهم وشيخوختهم ودفن مع أكفانهم وأحلامهم فالمبدع يولد بالفطرة مبدعاً ، وهؤلاء خرجوا من أرحام أمهاتهم ومعهم بذرة الإبداع ولكن رغم تجاهل الأهل وإهمالهم لهذه الموهبة ورغم شظف العيش وقساوة الحياة لم تستطع هذه الأمور أن تثنيهم عن إفراز ذلك النتاج الأصيل الذي سرى في عروقهم مسرى الدم دون مشيئة منهم وزادتهم إصراراً على التعبير ليس عن عذاباتهم ولهاثهم وراء رغيف الخبز فحسب بل كانوا بكتاباتهم يتحدثون بلسان حال أغلب أبناء مجتمعهم الذين قهرهم الفقر والحرمان. ومن منطلق أن الإبداع الأدبي مشروط بالمعاناة فالدولة ومؤسساتها الثقافية مازالت مقصرة حتى اليوم في إيلاء الإبداع والمبدعين التكريم اللائق بهم إلا بعد وفاتهم أو دنو أجلهم، وبما أن ثمة نسبة قليلة من الكتاب والفنانين البارعين فهنا تقع مسؤولية المهتمين بالحركة الثقافية في تحفيز المبدع ودعمه مادياً ومعنوياً وتذليل الصعوبات أمامه وتأمين مستوى حياة لائقة بإنسانيته وأدبه وفنه كي يتفرغ للأدب والفن وحدهما دون الاضطرار إلى التفكير بهموم تأمين قوت عياله، فالفنان والشاعر والأديب لابد أن تنمو بذرة نتاجه في بيئة صحيحة لتنمو موهبة متفردة تضمن لها الاستمرارية والصمود أمام كل زيف. فكما يوجد فنانون وموسيقيون وكذلك شعراء وكتّاب عاشوا في كنف أسرهم في بحبوحة مادية، ولم تطحنهم رحى الأيام وتدوسهم خطى القدر الأعمى لايمكن إلا أن نذكر من يقابلهم من نوابغ في عالم الموسيقا والفن والأدب والذين تركوا لنا أعمالاً غاية في الروعة كانت حصيلة جهد وإبداع سنوات طويلة مازالت خالدة إلى أيامنا ننفعل ونتأثر بها أمثال بيتهوفن الذي قدر له أن يعيش أغلب أيام حياته فاقداً حاسة السمع ورغم ذلك استطاع أن يوصل مشاعره للناس وتحويلها فناً ولحناً يخترق جدران القلب والعقل. وكذلك الكاتب الكبير طه حسين الذي لم تثنه إعاقته البصرية عن كتابة الروائع والأعمال الروائية الكبيرة، وغيرهم كثيرون نذكر منهم الأقرب إلى مجتمعنا المحلي الكاتب محمد الماغوط الذي كانت حياته مغلفة بالفقر والشتات والحزن، كما هي ميزة الشعراء الكبار أن يعيشوا الحرمان والبؤس والمرارة، فقد كان الماغوط يفترش الألم مع عائلته التي كان الفقر بيتها الواسع والجوع رفيقها الأبدي إذ قال ذات مرة «الجوع ينبض في أحشائي كالجنين». ثم جاءت تجربة السجن قبل بلوغه العشرين والتي غيرته من إنسان بسيط إلى كائن آخر يسكنه الرعب وتتقاذفه الكوابيس «السجن والسوط كانا معلمي الأول وجامعة العذاب الأبدية التي تخرجت فيها إنساناً معذباً وخائفاً». وإذا كان الماغوط ملكاً للسخرية في كلماته قصائده، فهذه التركيبة من السخرية والتلقائية والبدائية هي التي شكلت أعمال الماغوط وأعطتها تلك النكهة الفريدة وحولتها إلى أعمال درامية ومسرحية شهد لها بالروعة، ومع ذلك لم يكن الموت يخيفه بل كان في نظره هو الانقطاع عن الكتابة. ولأنه تمنى الموت ذكره في إحدى قصائده إلى بدر شاكر السياب، الذي توفي قبله «حزني طويل كشجر الحور لأني لست ممدداً إلى جوارك، ولكني قد أحل ضيفاً عليك في أي لحظة». وحتى قبل وفاته بسنتين ظل صامداً أمام المرض، وجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية التي نالها في دبي لم ينفق منها إلا على شراء الأدوية، وشراء السجائر والنبيذ اللذين ظلا متعته الوحيدة في آخر أيامه. وكذلك نذكر جبران خليل جبران كمثال آخر على مخاض إبداعي ترافق مع الألم والمعاناة فالحياة التي عاشها جبران لم تكن أفضل من حياة الماغوط، إذ إن والده كان يمضي أوقاته في الشرب ولعب الورق وكان صاحب مزاج سيء ولم يكن شخصاً محبباً وعانى جبران كثيراً من إغاظته وعدم تفهمه وشجاراته المستمرة مع والدته ، ثم أوقفت قوى الأمن الوالد لسوء إدارته الضرائب التي كان يجبيها فأدين وجرد من ثرواته، ماأربك الوالدة في كيفية إطعام أولادها الأربعة ففكرت في الهجرة وباعت كل ماتبقى من تركة والدها واستقرت في بوسطن مع أولادها في كوخ مظلم مع الكلاب الشاردة وبدأ عراكها اليومي في الحصول على مايسد رمق أولادها. أما مايخص حياة حنا مينه فقد كانت مسلسلاً طويلاً من العذاب إذ ولد من عائلة فقيرة عانت من التشرد والتنقل في قرى عديدة منعت ذلك أديبنا الكبير من استكمال تعليمه ، ولكنها لم تمنعه أن يبدع روايات ذات طابع مميز وأسلوب خاص. فضلاً عن أنه ولد عليلاً وكان الموت يتهدده ، عمل والده حمّالاً ولكنه كان فاشلاً يترك العائلة للخوف والجوع وكان سكيراً يشرب الخمر حتى يسقط فاقداً الوعي، وهذا ماجعل حنا مينه يعمل في مهن كثيرة، من أجير مصلح دراجات إلى مربي أطفال إلى عامل في صيدلية إلى حلاق إلى صحفي إلى كاتب مسلسلات إذاعية إلى روائي أخيراً ، فأسرته كانت تتلقى المساعدت والشفقة من الكنيسة وكان يقوم مع بعض أطفال المدرسة بالخدمة في الكنيسة وينام واقفاً فقد كان لحياته القاسية أثرها في رواياته حيث قال عنها «كنت أعاني البطالة والغربة والفقر والجوع وأحسد الكلاب لأن لها مأوى». ولكن حياته الشخصية الصعبة أغنت تجربته الأدبية وجعلت منها مادة متفردة نسج منها قصصاً تدور حول صراعه اليومي مع الفقر. ومن هنا فالإنتاج الجيد لايأتي إلا نتيجة معاناة صادقة يعيشها الكاتب، لذلك يجب على المبدع أن يستغل الظروف القاسية التي فرضها الزمن عليه قبل أن تخرسه وتأسره بدائرتها. وإذا كان الفقر والتشرد سينتجان لنا أمثال هؤلاء العظماء والقامات الأدبية والشعرية، فمرحباً إذاً بالفقر.
ْ
________*التــَّـوْقـْـيـعُ*_________
لا أحد يظن أن العظماء تعساء إلا العظماء أنفسهم. إدوارد ينج: شاعر إنجليزي