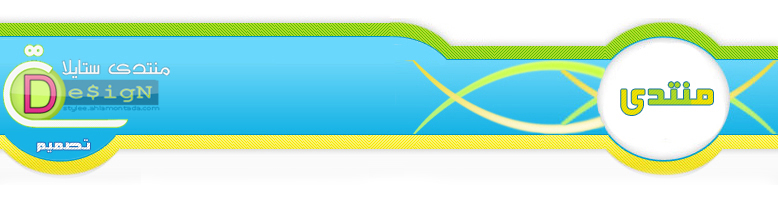بيداغوجيا المشروع
يقول فليب بيرنو بأن كل إصلاح للمنهاج الدراسي يستدعي ممارسات بيداغوجية جديدة تطال المدرس والتلميذ والمدرسة والمعارف والمضامين وطرق التدريس. ومن بين البيداغوجيات نجد التعلم التشاركي أو البيداغوجيا التشاركية، وهي طريقة من الطرائق التعليمية المبنية على المساندة والتعاون والعمل الجماعي أو في فريق يتبادل المعلومات. وهذا النوع من التعلم يمكن التلاميذ من تنمية مهارات شخصية كالثقة في النفس والقدرة على الإنصات، وقدرات اجتماعية كالتواصل واحترام الغير وفض النزاعات والإحساس بالانتماء... إلخ.
تعريف المشروع:
يعني المشروع ما نريد بلوغه بوسائل مخصصة لذلك باستراتيجيات يتم تنفيذها سواء أكانت استراتيجيات ناجعة أم غير ناجعة. والمشروع رؤية بعيدة أو قصيرة للمستقبل تتكون من عدة للتقويم وهي:
ü تحليل الحاجيات؛
ü تحديد الهدف أو الأهداف؛
ü اختيار الاستراتيجيات والوسائل (التمويل والآليات واللوجستيك والكفايات المطلوبة...)؛
ü تحديد المهام والمسؤوليات؛
ü تحديد الشركاء؛
ü التقويم.
المشروع هو ما نأمل القيام به، أو تصور وضعية أو حالة نتمنى بلوغها.وفي البيداغوجيا هو نوع من البيداغوجيا يسمح للتلميذ بإنجاز معارف معينة في ظروف ومدة زمنية محدودة أو سنوية.
تنقسم المشاريع إلى عدة أنواع منها[1]:
ü مشروع المؤسسة؛
ü مشاريع الأوراش الفنية؛
ü مشاريع الخرجات الدراسية؛
ü مشاريع الدعم التربوي وتهم التلاميذ الذين يعانون صعوبات في دراساتهم؛
ü المشروع الرياضي التربوي؛
ü مشروع الإدماج الذي يهم التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة؛
ü مشروع المساعدات الخاصة؛
ü مشروع الاستقبالات الخاصة الذي يهم الأطفال والمراهقين الذين يعانون مشاكل نفسية أو صحية...إلخ.
وأما آلان بوفيي فينطلق، في تعريفه للمشروع، من السؤال التالي: لماذا مشروع المؤسسة؟ إن التوقف عند المقاربة بالمشروع يعود بالأساس إلى الاهتمام بالعمل الجماعي وبالغايات ومعنى عمل المؤسسة: إلى أين نريد أن نسير جميعا؟ إنها محاولة للحصول على فكرة واضحة لتوجه المؤسسة و عن سياستها وعن قيمها المشتركة وأخلاقها. ويرى موريس نيفو من جانبه أن مشروع المؤسسة يوضح لماذا نشتغل يوميا، أو بشكل عام إن العمل بالمشروع من قبل المؤسسة هو وضع غاية لوظيفية النسق إن على شكل أهداف أو مشروع.
لا يكون المعنى معطى في المشروع لأنه مبني. وسيرورة المشروع تعمل على ظهوره وبنائه كما يتراءى ذلك من خلال المقاربة البنائية.
يتساءل محيط المدرسة كله، من آباء ومنتخبين وغيرهم، ماذا تفعلون هنا في المدرسة؟ ماذا تقترحون؟ لماذا تغيير البرامج والمناهج ووضع المسالك وطرق جديدة للتدريس؟ وما الذي يميز مؤسسة مدرسية عن أخرى؟ ويتبدى حسب آلان بوفيي أن مهمة العاملين في المدرسة لا تتوقف عند التلاميذ، أو بتعبير آخر إن التلاميذ ليسوا هم الزبناء الوحيدين رغم أنهم يمتازون بالأفضلية عن غيرهم.
لشركاء المدرسة أجوبتهم عن الأسئلة المطروحة أعلاه إلا أن أجوبتهم تتجاهلها المؤسسة. وفيما يخص المؤسسة فإن العمل بالمشروع يعنى إرادة التكيف المستمر مع المحيط ومع الطلب الاجتماعي ( التوجهات والانفتاح وفتح شعب جديدة أو إغلاقها والتحولات الداخلية...). فالمشروع هو إعلان عن تحول بالنسبة للمؤسسة المدرسية.
إن المؤسسة المدرسية هي نسق معقد يوجد في محيط أكثر تعقيدا؛ ولكي يتطور لا ينبغي التوقف عند متغير واحد وإنما على المجموع (الشمولية). فالمقاربة بالمشروع تحفز على التفكير بالشمولية من أجل العمل محليا لتفادي الشك النابع من المحيط، وخاصة الشك الشامل.
قبل الشروع في وضع المشروع يستحسن طرح بعض الأسئلة منها: كيف يتصرف الأفراد والجماعات وكيف يشاركون إزاء مشكل معين في المؤسسة؟ إن المشروع يمكن الجميع من التعلم الجماعي وتنمية معارف وكفايات جديدة. فمن أجل أن يكون الفاعل محفزا فهو في حاجة إلى معرفة إلى أين يسير فرديا وجماعيا. فالتحفيز والتعبئة والانخراط كلها من الأمور التي أصبحت لها أدوار أساسية في التدبير عامة بالنسبة لرئيس المؤسسة المدرسية. فهو لا يعمل على تغيير الأذهان وإنما يوفر المناخ للتغيير. ثم إنه قبل وضع مشروع معين يتساءل الفاعل قائلا: ما الفائدة من إنجاز هذا المشروع أو ذاك؟ وما الربح الذي ستجنيه المؤسسة من ذلك ويجنيه كل فرد وأنا واحد منهم؟.
لا وجود لإجابة عامة على هذه الأسئلة رغم عموميتها، ثم إنه لا وجود لتوافق حول ما يمكن أن ننتظره من العمل بالمشروع إن على المستوى الفردي أو الجماعي فالمقاربة بالمشروع، ندور بالنسبة للمؤسسة المدرسية حول ما يلي:
o الاستجابة لمشاكل معروفة، قليلا أو كثيرا، حيث تساعد المقاربة بالمشروع على تيسير معرفتها وتأطيرها ووضع دراسة بشأنها؛
o لا تمركز وتوزيع المسؤوليات والتسهيل والتشجيع على أخذ المسؤوليات والتفويضات؛
o تطوير تنظيم مؤسسة؛
o العمل على إظهار روح الانتماء داخل المؤسسة لجماعة ما، وتنمية التلاحم والهوية الجماعية والتضامن وتجاوز الصراع القبلي الداخلي؛
o الاقتراح الذي ينمي التكوين وتملك الطرق المنهجية الشاملة؛
o الحرص على تناغم مشاريع جميع الفرق ومختلف القطاعات والمستويات؛
o إضفاء مشروعية على التوجهات الرسمية والوزارية؛
o التواصل حول ما تراه المؤسسة المدرسية مستقبلا متكيفا ومستجيبا ومتوافقا مع محيطها.
إن المقاربة بالمشروع تريد أن تقول ببيان العبارة أن ممارسة التعليم نشاط تقليدي للغاية منظم وفق تصورات بيروقراطية. فقد كانت المطالب القديمة تلح على أن يقوم المدرس بعمل التدريس دون النظر إلى الغايات والمنتظرات والنتائج العامة المنتظرة، لكن حينما أصبح التعليم مرتبطا بالشغل لم تعد الأشياء مطروحة بنفس الشكل. والمطلب من المدرسة هي أن تعلم؛ وبمعنى أدق أن تؤهل الجميع دون ميز. ففي السابق كان المطلوب منها منح دبلومات لكن اليوم أصبح المطلوب هو تزويد المتعلم بتأهيلات معترف بها اجتماعيا، أي تأهيلات مرتبطة مباشرة بسوق الشغل مما جعل توجيه التلاميذ مسألة تحظى بوضع مركزي في الأنظمة التربوية، وحيث لا يكفي تحفيز التلاميذ لحيازة دبلوم معين وإنما السؤال هو لماذا ذلك الدبلوم بالذات؟وأي شغل يهيئ له؟ وفي أي وضعية؟... إلخ.
إن استحضار هذه الأسئلة يجعل التعليم في سياق تتداخل فيه الحدود، بالنسبة للتلميذ، بين ما ينتمي للحياة اليومية وما ينتمي للمدرسة؛ لذلك فإن التعليم لا يكفي وحده، وعلى المدرسة أن تكون وتربي؛ أي أنه على المدرسة أن تشتغل على نقل المعارف والمهارات وحسن التواجد، وفي الآن نفسه تشتغل على تهييء التلاميذ للاندماج في المجتمع.
تسمح المقاربة بالمشروع للآباء والتلاميذ والشركاء والمدرسين بالعمل معا ضمن مشروع اختاروه جماعيا وله معنى بالنسبة لهم جميعا، ورغم ذلك فإن مثل هذه الحجج لا تحد من المقاومات و وجهات النظر التي تنطلق من ثقافات وإيديولوجيات مختلفة أو تصدر عن جهل تام أو عن الإحباط أو تبخيس الفاعلين أو فردانية مطلقة ترفض العمل الجماعي. وحيث هذا الرفض لا يطال الغايات من المشروع أكثر من المشروع في حد ذاته.
يلح التدبير المعاصر على تعبئة الأطر الوسيطة أثناء وضع المشروع وتنفيذه في التنظيمات المقاولاتية، لكن من هؤلاء في المؤسسة المدرسية؟ إنهم المدراء الذين عليهم العمل على الإقناع والتحسيس والشرح والتفسير، إقناع الآخرين بأن المشروع يهم حاضر المؤسسة ومستقبلها.
لا شك أن المقاربة بالمشروع تعني توريط الفاعلين لأنه من المهم التوقف عند التعلم الجماعي (العمل على التمثلات) ويسر التواصل الداخلي والخارجي الذي ينميه المشروع، وهي من الأمور التي يمكن وضعها كأهداف تسمح بالتعلم وتكوين الفاعلين وتنمية التواصل.
توجد المؤسسة المدرسية بين التلميذ والوزارة الوصية، لكنه بين التلميذ والوزارة توجد مؤسسات كثيرة ويوجد شركاء كثر. لكل وسيط من هؤلاء أولوياته التي تحاول القضاء على أولويات الآخرين؛ ولذلك على المؤسسة أن تعي المناخ الذي تعيش فيه حتى تنمي قدراتها على التفاوض والحوار مع الشركاء، وبالتالي تؤكد هويتها الخاصة كمؤسسة مدرسية لا مؤسسة جهة من الجهات، مؤسسة مستقلة غير تابعة تؤكد استقلاليتها وتعمل على أن يتبناها الجميع، وتعرف بهويتها لشركائها وتعمل على نشر ثقافتها، وتكون قادرة على تمثيلها.ولكي تلعب هذه الأدوار عليها أن تعي تعدد الشركاء وتعدد الرهانات والخلفيات. ولا تغفل صورتها المتخيلة والفعلية، الصورة الداخلية والخارجية، والتمييز بين مشاريع الواجهة ومشاريع التكوين.
إن العمل على الصورة والهوية لمؤسسة مدرسية ليست سوى مرحلة من ثقافة المشروع لأن الاشتغال على الصورة والهوية ينميان التواصل الداخلي والخارجي.
لا ينبغي أن نغفل بأن المؤسسة المدرسية تنظيم خاص، وليست المسألة هي معرفة ما إذا كانت المؤسسة موجودة ومماذا تتكون وكيف تعمل، بل الأهم، في نظر آلان بوفيي، هو التركيز على الآثار والنتائج ومواصفات المؤسسات.وعلى العموم فإن المقاربة بالمشروع تسمح بما يلي:
o وضع غائية للمؤسسة، وتعنى إبداع مستقبل لأنه لا يمكن أن تظل المؤسسة المدرسية تحت رحمة النزوعات والرغبات؛
o ربط صلات بين المؤسسة ومحيطها حتى ولوكان المحيط متعبا لأنه لا يمكن للمؤسسة أن تعيش معزولة عن المحيط؛
o العمل على تغيير العلاقات العمودية بالعلاقات العرضانية لتفادي الجزر في العلاقات والتكتلات والصراعات القاتلة والبزنطية، والغاية هي أن يكون كل قطاع في خدمة الآخر داخل المؤسسة ويطالبه بما هو أحسن؛
o ينبغي الانتقال من منطق الخضوع إلى منطق المسؤولية؛ الحاجة إلى رجال ونساء واقفين لا جالسين؛
o معرفة إمكانات وقدرات كل فرد من الأفراد لأن الأمر يتعلق بتدبير للإمكانات لا تدبير الأجور؛ لذلك وجب البحث في أشكال جديدة للاعتراف.
بناء على هذه المحددات تشكل المقاربة بالمشروع قيمة مضافة بالنسبة للمؤسسة المدرسية لأنه بدون مشروع هل المؤسسة مستقلة فعلا؟ فكيف نصيغ مشروعا؟ وكيف ندبره؟ ولماذا المشروع؟.
يرى البعض أن المشروع كالفيزياء الكوانطية لا يقبل التحديد والتعريف، ومنهم من يرده إلى الهلوسات والتخيلات أو إلى الوعود والكلمات السحرية المليئة بالوعود، ويرى آخرون في المشروع لحظة مرور من فترة التعب والإرهاق إلى الرغبة في العمل، ومن الرغبة في العمل إلى القدرة على العمل ومن القدرة على العمل إلى العمل. فهل يشكل المشروع براديغما جديدا للتنظيمات؟.
يميز جاك أردوانو بين نوعين من المشاريع؛ أولهما المشروع الممركز على البرنامج (الأفعال والأشغال)، وثانيهما، المشروع المستهدف بخصائص قيمية ومقاصد فلسفية وأخلاقية ورؤية سياسية، وهو المشروع الذي يستهدف المستقبل وتطبعه البنائية أكثر من المشروع الأول. كما ترد عند ألان بوفيي نوعين من المشاريع؛ يسمي النوع الأول المشروع المنتوج الذي يستهدف إنتاج وثيقة مثلا، ثم المشروع المبني، وهو المشروع السيرورة الذي ينصب على المقاربة وطريقة إنجازها، بل هو المشروع الذي ينتقل من المشروع المنتوج إلى الترجمة الاستراتيجية والعملية. كما يتميز بالشمولية والاستباق والتحفيز ويشكل تصورا للتدبير والقيادة... إلخ.
ونذكر بأن المشروع، كل مشروع كيفما كان، يتميز بالسمات التالية:
o يجب أن يكون للمشروع جذور في تاريخ التنظيم ومحيطه؛
o أن يتميز المشروع بالأهداف الطموحة لمدة ما بين ثلاث سنوات إلى ثماني سنوات، أن يشكل تحديا جماعيا ومقصدا للجميع؛
o يجب أن يتناسب المشروع ونظام القيم؛
o يجب وضع سيناريوهات لإنجاز الهدف الرئيسي؛
o يجب التوفر على مخطط للعمل ومدى زمني متوسط؛
o يجب التوفر على أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية (وبيداغوجية بالنسبة للمؤسسة المدرسية)؛
o يجب التوفر على بعد تواصلي وتقييمي؛
o إن المشروع تعبير عن ذات جماعية وسيرورة تعلم جماعي؛
o المشروع أداة للاختيار استراتيجيا؛
o المشروع أداة للعمل والتعبئة؛
o المشروع مناسبة لاستثمار العناصر المحصل عليها في السابق؛
o المشروع موضوع تفاوض وحوار ومواجهة؛
o المشروع إمكانية للاستباق والمشاركة وتحميل المسؤولية والتواصل والتقويم وإظهار هوية المؤسسة وقيمها وتمثلاتها، وفرصة لعقد شراكات؛
o المشروع فرصة للتفكير في الزمن والتحكم فيه وتجاوز الزمن الدائري وولوج الزمن المنتج وزمن التقييم؛
o المشروع مناسبة لتحفيز الجميع؛
o المشروع مناسبة لتجاوز الرؤى التقنوقراطية والتسلطية؛
o المشروع مناسبة لميلاد المقاربات النوعية؛
o المشروع بالنسبة لمؤسسة تربوية مناسبة لإدماج الحياة المدرسية في التفكير؛
o المشروع مناسبة للتقويم الجماعي.
إذا كانت الخصائص التي ذكرناها تهم أي مشروع كيفما كان يظل السؤال مطروحا لمعرفة ما معنى مشروع المؤسسة التعليمية؟ وكيف يتم إنجازه؟ ولماذا أصبحت المدرسة تتكلم لغة المشروع كالمقاولات وباقي التنظيمات الأخرى غير المدرسية؟.
يجدر بالمدبر للمؤسسة التعليمية، قبل الشروع في مشروع المؤسسة، أن ينطلق مما يلي:
o تحديد الفاعلين والمشاكل والمتغيرات؛
o البحث عن المعلومة وتوثيقها؛
o إظهار وظائفية المؤسسة وروابطها مع محيطها وقيمها وإيديولوجيتها وتمثلاتها وكل ما له علاقة بثقافتها، أي بوصفها نسقا مفتوحا؛
o طرح المشاكل بما فيها المرغوب في حلها؛
o توريط جميع الفاعلين والشركاء في المشروع؛
o اللجوء للاستشارة والخبرة؛
o إبداع أفكار وحلول جديدة؛
o صياغة فرضيات وتكوين سيناريوهات؛
o تقويم إمكانية تطبيق السيناريوهات؛
o القيام بتشخيص يرتكز على المقاربات الوظيفية (البحث في الاختلال الوظيفي) أو المقاربة المؤسساتية(البحث في الرهانات وعلاقات السلطة) أو المقاربة النسقية ( الوصف الإجمالي للمؤسسة بما فيها التفاعلات والتواصلات والعلائق داخليا وخارجيا) أو المقاربة الاستراتيجية( البحث في الحاجة والأهداف والأدوار الخاصة بكل فاعل والجماعات والتحالفات) أو المقاربة الثقافية ( ملاحظة ووصف الرمزي والثقافات الداخلية والقيم و المقاييس والتمثلات والهويات الفردية والجماعية والصورة التي يتم تسويقها عن الذات والذوات والمؤسسة) أو المقاربة الإثنولوجية ( القدرة على إنتاج المعنى للواقع انطلاقا من تأويل ما ينتجه من يعيش ذلك الواقع) أو الانطلاق من مقاربات أخرى اقتصادية أو سسيولوجية بحثة.
ستقود هذه المقاربات (أو واحدة منها) إلى تشخيص يمكن من وضع مرجع يسمح بالقيادة والتقويم والمقارنات في الزمن، وتعرية تمثلات الشركاء.ثم لا ينبغي للمدبر أن يغفل وهو يضع مشروع المؤسسة التربوية مختلف المتدخلين الفاعلين في الحاضر والمستقبل في ذلك المشروع حتى يتبين له نوع التدخل والمهام والأدوار التي سيقوم بها كل فاعل من الفاعلين في الحاضر والمستقبل ليمر إلى تحديد مجموعة القيادة التي ستعمل على الاتصال والمراقبة ووضع دفاتر التحملات وتحفيز الفاعلين... إلخ،.كما لا بد للمشروع أن يستند إلى وثيقة مكتوبة تعمل كتعاقد بين الفاعلين والشركاء. والتعاقد ليس نقطة البداية وإنما هو نقطة الوصول.
لا يتأتى العمل بالمشروع من دون مخطط للعمل (اسم المخطط، الأهداف، معايير التقويم، الآجال، المكانة في المشروع، المسؤولون، الفاعلون، الشركاء، الاكراهات الواجب أخذها بعين الاعتبار، الموارد الرئيسية، خصائص أخرى، التعديل والقيادة). فالمخطط يهم الفاعل في تحديد الزمن والشركاء والأهداف.
تغير المقاربة بالمشروع دور رئيس المؤسسة التربوية كليا ليجد نفسه في حاجة إلى كفايات جديدة لأنه لن يعود قادرا على العمل بمفرده أو بمساعدة البعض من الفاعلين في المؤسسة بحكم الانفتاح على المحيط وتعدد الشركاء وضرورة الانخراط في المشاريع الجزئية والكبرى للمؤسسة التربوية والتحولات الاقتصادية التي ترمي بظلالها على المؤسسات التعليمية.وإن أول ما سيقوم به رئيس المؤسسة هو التعبير والتأكيد على إرادة المؤسسة ولعب دور التحسيس والمحرض وتفسير سياسية المؤسسة وتدبيرها ونوع العلاقات الإنسانية الجديدة. كما يجب أن يعطى المثال في الالتزام بالزمن واحترام الوقت وخلق جو الثقة والتمكن من طرق الحوار والتفاوض وتدبير الاختلاف والقدرة على التنشيط (تنشيط المجموعات واللقاءات إلخ...) والسهر على تنمية التواصل الداخلي والخارجي والتمكن من الحركات والتيارات البيداغوجية. وبالإجمال يجب أن يكون متمكنا من التحليل والاستباق وأخذ القرار، وقادرا على خلق جو لإنجاز المشاريع والمخططات والتكوينات والسهر على التقويم الدائم.
هناك جانب آخر من المشروع يتمثل في الشريك أو الشركاء: مشروع المؤسسة، لكن مع من؟ بما أن المؤسسة التعليمية أصبحت نسقا مفتوحا على المحيط فمعنى ذلك أنها في تفاعل مع الخارج ولم تعد مكتفية بذاتها كالنسق المغلق؛ لذا فهي تعمل على بلورة مقاربة تشاركية أو أنها لا تحيى إلا من خلال مقاربة المشروع مع الغير(الشريك).ولكن لماذا الإلحاح على هذه الموضة (الشراكة) الجديدة؟ وفيما تهم المؤسسة المدرسية هذه الموضة الجديدة؟.
يتداول التدبير الحالي لفظ الشراكة دون انقطاع حتى أصبح اللفظ متداولا في الحياة اليومية للأسر وجماعات الأصدقاء، إلا أن تداوله لا يستند إلى تصورات تنظيرية ولا إلى مقاربات تفسيرية: ما هو التحليل الذي ينبغي أن يستند عليه المتكلم في مقاربته للفظ الشراكة؟ ولماذا يستعمله الجميع بهذا الغموض؟ وهل يستقيم الحديث عن الشراكة دون مشروع وعن المشروع دون شراكة؟ هل تكون الشراكة بين الداخل والخارج أم داخلية كذلك؟ وهل الشراكة هدف في ذاته أم الشراكة وسيلة؟ وما هي الحدود التي ينبغي أن تتوقف عندها المؤسسة المدرسية في إبرام شراكاتها؟ وتعدد الشركات هل هو مفيد للمؤسسة التعليمية أم لا؟.
تتعدد وجوه شركاء المؤسسة التعليمية من أفراد وجماعات ومؤسسات مما يجعل التقويم الذاتي للمؤسسة يتناقص بفعل التعدد ومطالب الغير. لكنه مع ذلك فإن الشراكات تنمي الروابط والتفاعلات بين ثقافة المؤسسة والأنساق الثقافية الصغرى. كما تعدد من العلاقات بدل العلاقات الداخلية الجانبية والأحادية .
أول ما يجب تمييزه في الشراكات هو تمييز مستويات الشراكة حتى لا ينقلب الإشراك إلى مضمون فارغ وشكلي وبهرجي. ثم إن الشراكة لا تعني تغيير الأدوار التي يلعبها كل فاعل لأن الشراكة تنمي النوعيات لا تغيير المهن، كما تعني التكامل لا الإبدال. وأخيرا تكون الغاية القصوى من الشراكة هي الرفع من الجودة.
يطرح مشروع المؤسسة مشاكل في التواصل منها: إلى من سيقدم؟ لماذا؟ متى؟ وكيف؟ وذلك لتعدد شركاء المدرسة مما يجعل المدرسة أمام مشكل المهنية واللجوء إلى موارد خارجية مما قد يفقدها هويتها في بعض الأحيان.
لا شك أن التواصل مع الخارج يهم رئيس المؤسسة وفريق العمل أو قيادة المشروع، لكن ما يجب التشديد عليه أن التواصل بالذات والمشروع والشراكة كلها تخدم قضية واحدة هي الجودة.
يتم تداول الحديث عن الجودة أو يستساغ الحديث عن جودة المؤسسة التعليمية بدعوى أنها خدمة عمومية ينبغي أن تتوفر فيها شروط الجودة بالنسبة لمستعمليها.وعلينا أن نتذكر بأن مفهوم الجودة ينتمي للمقاربات المقاولاتية التي مرت من المراقبة التايلورية إلى استباق الاختلال الوظيفي. ففي بداية سنوات الخمسينات باليابان رصد أحد الباحثين بأن الجودة كانت مركزة على التقويمات المالية (الجودة واللاجودة)، برد الأخطاء إلى التدبير مثل أخطاء الإنتاج التي يتحملها الأطر وليس المنفذين.
ظلت المقاولات تعتقد لزمن طويل بأنه للجودة تكلفة وأما الآن فقد صارت الجودة خاصية أساسية للمنتجات والخدمات وأن اللاجودة هي التي أصبحت لها تكلفة.فماهي تكلفة اللاجودة في المؤسسة التعليمية؟
لابد من الإشارة إلى أن فكرة الجودة دخلت المجال العمومي متأخرة عن المجال المقاولاتي. ترتبط الجودة لدى المقاولة بمتطلبات الزبناء كموجه لها، ومع مرور الوقت تحول ذلك إلى مبدأ في الخدمة العمومية. وبدل الحديث المحتشم عن الزبناء صار الحديث عن مستعملي الخدمة العمومية. وأما من جهة تاريخ ظهور هذا المفهوم في الخدمة العمومية فيرجع إلى أواسط الثمانينيات من القرن العشرين.
قد يعود ظهور مفهوم الجودة في التعليم إلى البحث عن التكلفة؛ وبخاصة تكلفة اللاجودة، حيث يظهر بجلاء أثر التدبير التشاركي.
خلاصات:
يتمثل المشروع التربوي البيداغوجي، حسب فليب بيرنو، فيما يلي:
أولا: المشروع مقاولة جماعية تدبرها جماعة القسم (المدرس ينشط لكنه لا يقرر).
ثانيا: يتوجه نحو إنتاج ملموس (في المعنى الواسع مثل إنجاز نص، عرض مسرحي أو غنائي، عرض، مجسم، خارطة، تجربة علمية، رقصة، أغنية، إبداع فني أو يدوي، حفلة، بحث، تظاهرة رياضية، سباق، مباراة، لعبة، إلخ...).
ثالثا: إدخال مجموعة من المهام تسمح بتوريط جميع التلاميذ وجعلهم يلعبون دورا نشيطا يتغير حسب وظيفة وسائلهم ومصالحهم.
رابعا: إحداث تعلمات للمعارف ومهارات تدبير مشروع (اتخاذ القرار، التخطيط، التنسيق إلخ...).
خامسا: يسمح المشروع بتعلمات قابلة للتحديد كما توجد في البرنامج الدراسي لتخصص وعدة تخصصات (الفرنسية، الموسيقى، التربية البدنية، الجغرافيا إلخ...) (...).
ومن الجهة البيداغوجية التعلمية الصرفة يرى فليب بيرنو أن للمشروع وظائف متعددة منها:
أولا: يتسبب المشروع في تعبئة المعارف والمهارات المكتسبة وبناء كفايات.
ثانيا: التعاطي مع الممارسات الاجتماعية التي تنمي المعارف والتعلمات المدرسية.
ثالثا: اكتشاف معارف جديدة وعوالم جديدة في منظور تحسيسي أو تحفيزي.
رابعا: الوقوف أمام عوائق لا يمكن تجاوزها إلا بتعلمات جديدة قد تقع خارج المشروع.
خامسا: إثارة تعلمات جديدة في إطار المشروع نفسه.
سادسا: يسمح المشروع بتحديد المكتسبات والنواقص في إطار منظور التقويم الذاتي والتقويم- الحصيلة.
سابعا: تنمية التعاون والذكاء الجماعي.
ثامنا: مساعدة كل تلميذ على أخذ الثقة في النفس وتعزيز الهوية الفردية والجماعية.
تاسعا: تكوين التلميذ على تصور وقيادة المشروع.
عاشرا: تنمية الاستقلالية والقدرة على وضع اختيارات والتفاوض بشأنها.
تقويم مشروع بيداغوجي:
قلنا فيما سبق أن للمشروع مراحل متعددة، ولذلك فإن تقويمه يتخذ أشكالا تختلف بحسب المراحل المكونة له والأهداف والكفايات المتوخاة ودرجة انخراط المتعلمين فيه ورؤيتهم إليه ومدى تنميته للكفايات المستعرضة.
ويمكن إجمال أنواع تقويم المشروع البيداغوجي[2] فيمايلي:
ü تقويم المراحل البيداغوجية للمشروع؛
ü تقويم موقعة المشروع بيداغوجيا؛
ü تقويم وصف المشروع؛
ü تقويم تتبع المشروع؛
ü تقويم لوحة قيادة التلميذ؛
ü تقويم التقديرات الجماعية للمشروع.
ü تقويم التعلمات المستهدفة؛
ü تقويم الكفايات العرضانية؛
ü تقويم الحصيلة: الأهداف.
ْ
________*التــَّـوْقـْـيـعُ*_________
لا أحد يظن أن العظماء تعساء إلا العظماء أنفسهم. إدوارد ينج: شاعر إنجليزي